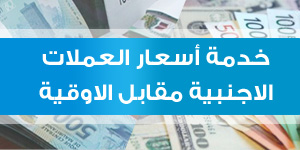يذكر عبد القاهر البغدادي (ت: 429) أن علماء الكلام كانوا يسمون المعتزلة "مخانيث الخوارج". وذلك "لَأن الْخَوَارِج
لما رأوا لأهل الذنوب الخلودَ في النار سمّوْهم كفرةً وحاربوهم. والمعتزلةُ رَأَتْ لَهُم الخلود في النَّار وَلم تجسُر على تسميتهم كفرةً ولا جَسَرَتْ على قتال أهل فرقة منهم فضلا عَن قتال جُمْهُور مخالفيهم". (الفرق بين الفرق، بيروت 1977)، 99.
وبذا، فالمعتزلة تبنّوا أفكار الخوارج إلا ما يحتاج منها لدفع ضريبة فادحة. فنجحوا بذلك في الإفلات من تحدي المواقف اليومية ومقارعة الظلمة، وارتفعوا إلى الأُطُر النظرية المغلقة لخوض معارك وهمية باردة دون ضريبة. وتركوا بذلك مقارعة الظلمة، مُتوعدين إياهم بأن الملائكة ستقارعهم... في اليوم الآخر. ورضِيَ الحكامُ بإرجاء الأمر ليوم الحساب.
وقبل الحديث عمّن نعني هنا بالعنوان أعلاه، نُذكِّر بأنه يمكن تقسيم العاملين في المجال للإسلام إلى فئتين: فئةٍ منخرطة في العمل السياسي والدعوي داخل أُطُر وأحزاب. وآخرين مستقلين يسددون ويقاربون عاملين للإسلام بطريقة حرة.
غير أنه نبتتْ نابتةٌ أخرى -على لغة الجاحظ-على أطراف الإسلاميين الحركيين تتدثر بالسمت الخارجي لهم، وتتبنى أفكارا تناقض مشروعهم الحضاري. فهي تتمسك بفكرة غائمة ترى أن الإسلام حق، وذو مشروع حضاري، لكنها تتنكب الأفكار التي تحتاج لدفع ضريبة ما. كفكرة الدولة الإسلامية ومعارضة الأنظمة والشغَب عليها.
والمِهاد الاجتماعي -حتى لا أقول الفكري- لهؤلاء غالبا مهادٌ إسلامي في البدايات. فمعظمهم تربى في أسرة إسلامية، أو تلقفتْه أيدٍ إسلامية خيّرة فعلمته ووضعت قدمه على طريق الحياة. ويمكن تقسيمهم إلى فئتين:
قوم عاشوا داخل الحركات الإسلامية عندما كانوا ضعفاء، حتى إذا اشتدتْ سواعدهم هربوا إلى معسكر العدو "ليصبحوا مختصين في الحركات الإسلامية"، على لغة صديقنا عبد الله الطحاوي. وهو تخصص لا يدخل في باب اختصاص الدارس الذي اختار موضوعا للدراسة، وسلخ من عمره سنين لتأمله، بل هو من باب اختصاص من ترك جيش قومه لحظة الزَّحف، والتحق بمعسكر العدو ليُحدثهم عن اسم قائد الجيش، وأسماء نوابه، وطرق التموين، والأبواب المؤدية إلى مخابئ الأطفال والنساء.
وهؤلاء "المختصّون" في الحركات الإسلامية مولعون بكل ما يقدح في الفكرة الإسلامية دون الجرأة على التصريح بذلك. لأنهم غالبا قادمون من أُسَر محافظة، ومرتبطون بعلاقات مصلحية بكثير من الإسلاميين، فلا يملكون الشجاعة للحديث عما يضمرون من عداء للفكرة الإسلامية -وللإسلام أحيانا- فيتعلقون بأقاويل العدو التي تقدح، مُلبِّسين ذلك بعباءة النقد البريء، وهم معادون لكل ما يطمح الإسلاميون لتحقيقه.
ولعل مواقف معظمهم في موجة الربيع العربي وبالذات في بلدان الثورة خير شاهد. إذ أصبح كلهم من "شباب الثورة" الذين يَشْغَبون على أنصار الحرية الجادّين، ويزايدون عليهم، حتى إذا جَدَّ الجد واحتاجت الحرية لدفع الثمن تواروا وهم يسلقون أنصار الحرية بألسنة حداد أشحة على الخير.
أما الفئة الثانية فيشتركون مع الصنف الأول في ظروف النشأة وتحكّم العُقَدة من الإسلاميين. فوجودهم وجودي سلبي، فرع عن وجود الإسلاميين ولا يستطيعون العيش -أو التّعَيُّشَ على الأصح- في عالم ليس به إسلاميون، وهم أشبه بحالة المعتزلة والخوارج التي صدرنا بها هذا الحديث.
فَهَمُّهُم نقد الإسلاميين الحركيين لانشغالهم بالسياسة والشأن العام، ويصنعون لأنفسهم عالما افتراضيا، ويستوردون أسئلة مريحةً يطيرون إليها فرارا وجبناً من واقع لا يملكون من يقظة الضمير، والصبر على المجالدة ما يسمح لهم بالتعاطي معه. فيُحدِثون خطابا يتهم الإسلاميين بأنهم لا يعرفون ماذا يريدون، وأن الإسلام لا يمكن أن يطبق في الدولة المعاصرة، وأن الدولة المعاصرة لا تصلح للعيش أصلا. وإذا قلت شطر كلمة عن الدولة التي ينتمي إليها أحدهم انتفخت أوداجه.
وإذا سألتهم عن البديل عن الدولة كَعُّوا، ورددوا -بطريقة ببّغائية- أدبيات تيار أوروبي مهووس بعيوب دولة رأى خيرَها وشرَّها، وديمقراطية عَبَّ من رحيقها حتى ثمِل. يفعلون ذلك مستخدمين مصطلحات إسلامية، فأصبحوا بذلك "إسلاميين" دون أن يجهروا بموقف أو يدافعوا عن عدالة أو يدفعوا ضريبة موقف.
والمأزقُ المنهجي -دعْ الأخلاقيَّ- لهؤلاء يكمن في أنهم لم يعيشوا قط في فِناء دولة بتلك المواصفات التي يرددون عيوبها، ولا أظلتهم ديمقراطيةٌ حتى يكتشفوا عيوبها. فيسخّر أحدُهم وقتَه للحديث عن مثالب الديمقراطية، وهو لا يأمن على نفسه، ولا يملك شيئا من أمره؛ بل تتعاورُه أيدي العساكر صفعا، وهو مشغول بسلق الأحرار من بني قومه المقيمين وراء القضبان سعيا لتحريره وتحرير أمته.
ولأن أي مجرم في الدنيا لابد أن يجد تبريرا لجريمته مهما كانت بشاعتها، فهم يدَّعون أن تَصَدُّر الإسلاميين لطلب الحُكم أمرٌ يخالف الفكرة الإسلامية الزاهدة في حُكم الناس أصلا، مُدَّعين أنهم إنما يتركون الدفاعَ عن حقوق الناس من هذا الباب.
ولعل أول من كشف بعمق عن أن هذا المنزع ناتجٌ من خاصَّتيْ الجُبن والبُخل هو ابن تيمية حين قال: "وكثيرا ما يشتبه الورعُ الفاسدُ بالجبن والبخل: فإن كليْهما فيه تركٌ؛ فيشتبه ترك الفساد؛ لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة: جبناً وبخلا. (..) وكذلك قد يترك الإنسانُ العملَ ظنا أو إظهارا أنه ورع؛ وإنما هو كِبرٌ وإرادة للعلوّ". (السياسة الشرعية، جدة: 1418)، 466.
ولقد وضع ابن تيمية يده على الحالة النفسية لهذا الصنف من الناس في الفقرة الأخيرة. فمنزع سَلْق الإسلاميين من "مخانيثهم" إنما هو "كِبر وإرادة للعلو"، دعا إليه عجزهم عن تحصيل المكانة من أبوابها الطبيعية، فنكصوا يذمّون -جبناً وبخلا- من يدفع ضريبة خدمة الإسلام الباهظة، ساكتين عن الظلمة.
وهكذا يصبح "مخانيث الإسلاميين" أشبه بالدمى المعروضة في السوق. فأشكالهم ومصطلحاتهم تشبه الإسلاميين، يحافظون على المظاهر الخارجية لكنهم في الواقع لا يؤمنون بالفكرة الإسلامية الهادفة لتعبيد الناس لله، وقيام الناس بالقسط. فَهُم تجسيدٌ للصورة النوَّاسية؛ حيث يمشي أحدهم في سمتِ أبي ذر، وتضطرب جوانحهُ ومآلاتُ آرائه بأفكار أبي جهل:
أيا ابنَ أبانٍ هل سمعتَ بفاسق *** يُعدّ من النُّساك فيمن مضى قبلي؟
ألم ترَ أني حين أغدو مُسَبِّحا *** بسمتِ أبي ذر، وقلب أبي جهل!
إنَّ هؤلاء يتجاهلون أمراً فهمه الأعرابي حين عرض عليه النبي صلى عليه وسلم فكرة الإسلام في منىً قبل أربعة عشر قرنا، فردّ عليه بصدق: "هذا أمرٌ تكرهه الملوك!". والقوم يكرهون ما تكرهه الملوك.

.jpg)
.jpg)
.gif)








.jpg)