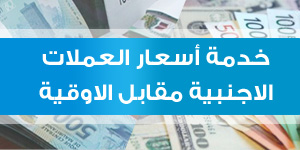إذا كانت نظريات السلوك السياسي، التي تُعتبر بحق أحدَ جوانب العلوم السياسية، تحاول قياس وتفسير المؤثرات التي تحد الآراء السياسية للأشخاص و الايديولوجيا ومستويات المشاركة السياسية، فإنها غائبة عندنا لضحالة مجالها و غياب وعائها. و مع ذلك فإننا اليوم في أمس الحاجة إليها لنهتدي إلى رؤية آخر النفق المظلم الذي ولجناه منذ الاستقلال مُعَصِّبِي الأعين حاملين على أكتافنا و في نفوسنا كل إرث الماضي من الفوضى و الممارسات التي تمس جوهر النظام و الانضباط و تُقوِّض العدل و تنبذ العمل البناء و لا تبالي بضرورة الوجود المتميز في عالم تكتسحه العولمة.
و من المعلوم أنه عندما تختفي القيم ويسود النفاق في مجتمع ما و تتسع الحاجات إلى بيع الذات من أجل لقمة العيش من إملاق أو مال يجتنى بسهولة التملق و الغش أو موقع يحرز بالنفاق فإن قوى الانتهازية السياسية تجد ضالتها لإفشال أي توجه عادل أو مشروع نافذ إلى قيام دولة القانون و المواطنة و الديمقراطية، و تضيعُ في متاهات الخواء الأصواتُ التي تنادي بالإصلاحات الجذرية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
و في المجتمعات التي لم تعرف يوما حكما مركزيا من أي نوع كان، و لا فكرا قياديا بأي مقياس أو أسلوب، و لا تعاطيا سياسيا بأي حجم أو مستوى من التطبيقات و الممارسة لتسيير أجواء حراكها و حفظ حيز تجمعاتها العامة و تنظيم احتياجاتها المتناقضة و توفير ضرورات استقرارها في بيئة تحيط بها الهشاشة، فإن تصحيح هذه الأوضاع الشاذة يصبح أمرا أشد بروزا و دواعي التصحيح أكثر إلحاحا.
و لا شك من هنا مطلقا أن بلادنا تنتمي شكلا و مضمونا لهذا الصنف من الدول مهما كان الذي يشاع على ألسنة البعض من نظريات تاريخية تريد تأكيد أنه عبر التاريخ وجدت على هذه الربوع المقفرة أحكام مركزية أو نشطت مؤسسات تنظيمية ضبطت مسار البلد في حيز معلوم الحدود و موثق حقب شهدت قيام نواة مركز قرار قوي و سلطة قانون غالبة كان لها آليات فعالة و وسائل ضبط مكينة، و حيز اقتصادي يوائم بين إنتاج محلي و تبادل مؤمن و يمتلك قدرات تسييرية محكمة. و بالطبع فإن هذا لا ينفي وجود حواضر/محطات على طريق القوافل (ولاتة، تيشيت، شنقيط، وادان) اشتهر من بين أهلها أفذاذ بالعلم الرصين و الألمعية الراجحة رغم بيئتهم الظالمة و احتمائهم وراء الأسوار و اللجوء إلى الهجرة كما فعل بعضهم إلى بلدان تحكمها سلط مركزية و شرعٌ نافذ بَيِّنٌ في المغرب الأقصى و بلاد المشرق، و بَقي منهم من لم يُرفع له شأنٌ بعد أن قضى و لا ثُبت عنه رسم ليُهتدى إليه و إلى كامن أثره.
و هي ذاتها النظريات ـ المتغنية بإسراف شديد بأمجاد من قضوا و لم يحفظوا ـ التي تذهب إلى أننا أحفاد قادة سرت على أيديهم و بحكمتهم حقب التاريخ حافلة برسو قواعد الدولة و استحكام مقوماتها العتيدة حتى بات فعل الاستعمار في رسم الحدود و تسمية البلد و منحه الاستقلال كيانا معلوم الحيز و وضع قواعد التأسيس من باب تحصيل حاصل انكفائه و بُعد لزوم اختيار العاصمة نواكشوط و العلمَ و تلحين النشيد و وضع المؤسسات التسييرية الأولى قيد العمل و الحصول على مقعد في الأمم المتحدة.
و أما التعاطي السياسي في قوالب حزبية قبيل الاستقلال و حركية لاحقا في عصر الحزب الواحد فإنه لم يكن أيضا بفعل و تأطير ذات المستعمر و وضعه أسس اللعبة السياسية في بلد بدأت معها و وقتها مراجله تهدئ من غليانها. و بالطبع فإنه لو لم تفشل الأحزاب و سياساتها التي تخضبت عند نشأتها أول مرة بالمفاهيمية القبلية و العشائرية و الإثنية و مساوئها الجمة كلها لكان المستعمر قد نجح في وضع أسس متينة للديمقراطية و الدولة القوية كما فعل مع بلدان أخرى استقامت بالإرث الحزبي ذو الطابع المحلي و هي دول تحقق يوما بعد يوم تطورا متناميا في مسار ترسيخ قواعد دولة "القانون" و "المواطنة" و تنجح و لو بصعوبة في اجتثاث رواسب الماضي المتبقية. أما عندنا فإن ثقل و قوة كوابح الماضي التراتبي الذي ينبذ النظام بشدة و يكره العمل هو الذي ما زال يلقي بظلاله على مسار "الكيان" و يقوض جهود الخيرين القلائل الماخِرين عباب بحر الحائرين من فوق موجه سفن الموغلين في تكريس حكمه المتحجر و الإصرار على جني ثمار ظلمه و حيفه على البلاد و العباد.. قَبليةٌ و إن تآكلت بنيتها التقليدية و تحولت إلى أسرية مستأسدة، و إثنيةُ و إن تساقطت بعض أعمدتها إلا أنهما ما تزالان تراوغان جديد الوعي و تكيلان له من الطعنات لتظل على رأس اللعبة السياسية المختلة بدون عناء صنع خطاب منهجي و لا وضع مشروع اجتماعي و برامج تنموية و من دون بلورة رؤى استشرافية متوازنة.
و لا يرتبط ضعف الدول و فشلها بالأنظمة أكثر مما هو مرتبط في الواقع بطبيعة البنية الاجتماعية و مدى تأثيرها في صياغة مفاهيم العدالة و الوطنية و العمل و الواجبات و الحقوق و صيانة الأمن الداخلي و الحفاظ على اللحمة الاجتماعية و الدفاع عن الحوزة الترابية.
و لما أن الأطر الحزبية و المؤسسات المنتظمة في عقد المجتمع المدني هي المعنية الأولى باحتضان هذا التوجه و بلورة عملها حول أساسياته فإن فشل الدولة متوقف على عجزها أو غفلتها أو تهاونها في هذا المجال الذي تأسست لأجله و تبنت فلسفته. و قد اعتُمِد لتمييز الدول الفاشلة في العالم مؤشرٌ يستخدم اثنا عشرة معيارا رئيسيا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لقياس فشلها. و من تلك المعايير سيادةُ حكم القانون، احترام حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية، تبني الديمقراطية، رفع مظالم المجموعات، التنمية المتوازنة، لأنه بغياب هذه المعايير العالية فإن أركان الدولة لن تجد بدا من الانحسار ليسود فيها الغبن و تعشعش المفاهيم الماضوية بكل شراستها.
أما و قد ثبت أن الذين يقربون الدولة إلى الفشل هم السياسيون الخارجون على مواثيق الوطنية و اللا مبالون بوحدة صف المواطنين و نشر العدالة بينهم، المتمردون على اشتراطات المدنية و مقوماتها السامية، فإن فشلها ليس مع ذلك قضاء وقدرا، حيث من الممكن و بفعل انتظام إرادة بعض أفراد الشعب الغيورين بوعي ثاقب و حضور قيادات مستنيرة راشدة تخرج من بين الصفوف ـ تخطط و ترسم و تتبع سياسات ديمقراطية وإصلاحات تُشعر المواطن بأنها حريصة على مصالحه و تسعى إلى إبعاد الحيف عنه و تحسين دخله المادي و الرفع عنه شح احتياجاته الضرورية من السكن والعلاج و التوظيف ـ أن تخرج من قمقم الكيان التقليدي الراكد الذي توجهه التكتلات الاجتماعية التقليدية إلى قوة وضغط التغيير لتلائم بين نظام الدولة المستجدة واحتياجات شعبها و من ثم تمضي سريعا إلى التحول المتوازن حتى تصبح نموذجا إيجابيا يقتدى به.

.jpg)
.jpg)
.gif)








.jpg)