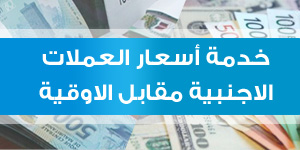مع اقتراب العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين من نهايته أصبح موضوع فرض العقوبات من أكثر الاجراءات تطبيقا من جانب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
العقوبات الاقتصادية حسب التفسيرات الأكاديمية، هي جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. قد تشمل العقوبات الاقتصادية أشكالا مختلفة من الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعاملات المالية. تهدف العقوبات الاقتصادية عموما على إرغام حكام الدول المستهدفة بتلك العقوبات على تعديل سياستهم. فالوسائل المستعملة وسائل اقتصادية، لكن الرهان والمرمى سياسيان. إن الدولة أو الدول التي تقرر إنزال عقوبات اقتصادية تسعى إلى الضغط على السلطة السياسية للبلد المستهدف.
تكون العقوبات الاقتصادية على طريقتين أما حظر أو مقاطعة، ويكون الحظر على هيئة تعليق تصدير منتج تجاري بعينه إلى هذا البلد، أو عندما يتخذ قرار بفرض حظر تجاري، جزئي أو تام، يكون الهدف "إحراج" البلد المستهدف. اما المقاطعة تتم عبر رفض استيراد منتج بعينه مصدره البلد المستهدف. كما يمكن النظر كذلك في عقوبات مالية، كوقف القروض والاستثمارات أو تجميد الحسابات المالية في الخارج. تشمل العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف.
وفقا لبيانات باحثين، فإن تغيير النظام، وهو الهدف الأكثر شيوعا للسياسة الخارجية للعقوبات الاقتصادية، حيث يمثل ما يزيد قليلا عن 39 بالمائة من حالات فرضها.
يناقش الباحثون فعالية العقوبات الاقتصادية في قدرتها على تحقيق الغرض المعلن عنها. باحثون غربيون زعموا أن 34 في المئة من الحالات كانت ناجحة في دراساتهم.
ووفقا لدراسة بريطانية اجريت سنة 2015 كان للعقوبات الاقتصادية الأمريكية تأثير مهم إحصائيا على اقتصاد البلد المستهدف عن طريق خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 2 في المائة سنويا. وخلصت الدراسة أيضا إلى أن الآثار السلبية تستمر عادة لمدة عشر سنوات وتصل إلى انخفاض إجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المستهدف بنسبة 25.5 في المائة.
إن فرض العقوبات على الخصم يؤثر أيضا على اقتصاد البلد الفاعل إلى حد ما. إذا تم فرض قيود على الاستيراد، فقد يكون المستهلكون في الدولة الفرضية قد قيدوا خيارات البضائع. إذا تم فرض قيود على التصدير أو إذا كانت العقوبات تمنع الشركات في الدولة الفرضية من التجارة مع الدولة المستهدفة، فقد تخسر الدولة الفائزة الأسواق وفرص الاستثمار للدول المنافسة.
يقدر الدبلوماسي البريطاني جيريمي غرينستوك أن سبب شعبية العقوبات ليس في كونها معروفة بفعاليتها، ولكن "لا يوجد شيء آخر بين الكلمات والعمل العسكري إذا كنت تريد ممارسة الضغط على حكومة ما".
صحيح أن مفعول تأثير العقوبات الاقتصادية على الدول تحتاج إلى وقت أطول من العمل العسكري لكنه سلاح غير مكلف كثيرا لأمريكا إلا إذا اصطدمت مع قوة تملك مقومات اقتصادية وثروات طبيعية كثيرة ومتنوعة، وكذلك إذا كانت لا تعتمد في اقتصادها على عوامل وعناصر خارجية.
المقاطعة
منذ ما يقرب من قرن من الزمن، طرح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، قضية العقوبات الاقتصادية، وهو يدافع عن عصبة الأمم، وقال: "الأمة التي نقاطعها هي أمة على وشك الاستسلام".
وأضاف: "طبق هذا العلاج الاقتصادي والسلمى الصامت والمميت، ولن تكون هناك حاجة لاستخدام القوة، إنه علاج رهيب لا يكلف حياة خارج الدولة التي تقاطعها لكنه يفرض ضغوطا عليها، وفى رأيي أنه لا توجد دولة حديثة يمكن أن تقاوم".
بالنسبة إلى ويلسون، كان الجانب الاقتصادي للحرب العالمية الأولى هو الذى ساعد على هزيمة ألمانيا، ومن المفارقات بالطبع أن بلد ويلسون لم ينضم أبدا إلى عصبة الأمم، حيث لم يكن مستعدا بعد للعب دور نشط على المسرح العالمي، لكن بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الولايات المتحدة الانخراط مع العالم والاستفادة من مكانتها كقوة عظمى عالمية لفرض عقوبات اقتصادية بدلا من الصراع المسلح، وبالتالي تحقق أهداف سياستها الخارجية.
يقول تحليل نشره موقع معهد ستراتفور للأبحاث الأمنية والسياسية الأمريكي، إن العقوبات الاقتصادية ليست اختراعا أمريكيا، لكنها تعود إلى الحضارة اليونانية القديمة على الأقل عندما منع القائد اليوناني بريكليس سكان مدينة ميجارا من دخول موانئ وأسواق أثينا.
وقد نشب جدال حول فعالية هذا الحصار بطبيعة الحال قديما، فبعد كل شيء تسبب ذلك في إشعال حرب بيلوبونيز، التي لم تنته بشكل جيد بالنسبة لأثينا حيث انتصر تحالف إسبرطة، وهيمن على اليونان.
الدور المالي المهيمن
دور الولايات المتحدة المركزي فى النظام المالي العالمي والقوة الدولية للدولار أعطياها فرصة فريدة لخنق الدول الأضعف أو الاطراف بمختلف أنواعها شركات وأفراد وغيرها التي تعتبرها معادية أو خصم من خلال القطاع المصرفي.
وبما أن الدولار يمثل العمود الفقري للتجارة الدولية والتمويل وتجارة البترول وغالبية المواد الخام، كما أنه العملة الاحتياطية المفضلة للبلدان في جميع أنحاء العالم وعلاوة على ذلك، تحتاج البنوك الدولية للوصول إلى النظام المالي الأمريكي لتداول وتصفية المعاملات بالدولار.
وهكذا، ببساطة عن طريق إلقاء ثقلها في القطاع المالي يمكن للولايات المتحدة إنشاء هياكل تشريعية ذات تأثير عالمي مثل قانون باتريوت، والأمر التنفيذي رقم 13224، الذى يجبر البنوك على الامتثال لإملاءات واشنطن.
ويمكن إعطاء مثال تطبيقي للممارسة الأمريكية عندما تسمى الولايات المتحدة بنكا أو جماعة أجنبية ككيان مستهدف.
من الناحية الفنية، لا ينطبق قانون الولايات المتحدة بشكل مباشر إلا على البنوك التي لديها تعاملات مباشرة مع البنوك الأمريكية، ولكن لأن البنوك الأجنبية الأخرى لا ترغب فى أن تقوم الولايات المتحدة بإدراجها فى القائمة السوداء، بسبب ارتباطها بالبنك أو الكيان المعين، وبالتالي عزلها عن النظام المالي الأمريكي فإنهم يقطعون العلاقات مع الكيانات التي تحظرها واشنطن، وهذا يمنح العقوبات المالية للولايات المتحدة مدى بعيدا بطبيعته، ويضمن أن العقوبات الأمريكية تجعل هذا البنك أو الجماعة مثل الجسم السام في الساحة الدولية.
مدى فعالية العقوبات
تأرجح نجاح أو فشل نظام العقوبات ارتبط بعوامل متباينة، فهو يحقق نجاحا متفاوتا عندما تشارك فيه دول عديدة ذات اقتصاديات قوية خاصة إذا كان عبر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، كما تأرجحت فعاليته نتيجة التوازنات الدولية. ففي فترة ثنائية القطبية العالمية عندما كان الصراع دائرا بين الغرب بزعامة الولايات المتحدة والكتلة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين، لم يكن فعالا لأن الاتحاد السوفيتي كان يساند الدول التي تتعرض للعقوبات الغربية وبالتالي يضعف نتائجها. وقد تجلى ذلك مثلا في الحصار الأمريكي على كوبا خلال ثلاثة عقود من سنة 1959 وحتى 1990. كما أفشل الغرب لفترة ليست بالقصيرة العقوبات الدولية التي فرضت على جنوب أفريقيا خلال حكم الفصل العنصري. دول عدم الانحياز بدورها نجت إلى حد كبير من الضغوط الغربية والأمريكية أساسا بفضل الدعم السوفيتي ثم الصين الشيوعية عندما بدأت تتعزز بنهضتها.
الأمور تبدلت بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي ونجاح الولايات المتحدة في التحايل على اتفاقية بريتون وودز التي كان هدفها خلق نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العالم، حتى نجحت في الغاء ارتباط العملة الورقية النقدية بالذهب وأحلت مكانها الدولار الأمريكي.
تجارب متنوعة
العقوبات التي فرضت تحت راية الأمم المتحدة على العراق من سنة 1990 وحتى غزوه وإحتلاله سنة 2003 تعتبر مثالا فاضحا للوحشية وفي نفس الوقت لعدم قدرتها على الوصول إلى النتائج المرجوة من طرف واشنطن. فهي لم تسقط النظام العراقي عن طريق دفع الشعب للثورة على حكامه، مما أجبر إدارة البيت الأبيض في النهاية على ركوب مخاطر الغزو الذي كلفها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار وحوالي 5800 قتيل وعشراء آلاف الجرحى من الجنود الأمريكيين. لكن الحصار والعقوبات ذهبت كذلك بحياة أكثر من مليون مدني عراقي.
عندما سئلت سفيرة الأمم المتحدة مادلين أولبرايت سنة 1996 عن وفاة نصف مليون طفل عراقي بسبب العقوبات الأمريكية، كان ردها صادما: "نعتقد أن الثمن يستحق ذلك". ومع ذلك، فإن الحرب الاقتصادية تفشل في كثير من الأوقات، خاصة إذا كانت الجهود أحادية الجانب لقوة واحدة تطبق ضد بقية العالم.
في كتابها "الحرب الخفية" كشفت أستاذة العلوم السياسية الأمريكية "جوى غوردن" فساد الاعتقاد السائد بأن العقوبات وسيلة سلمية وغير مؤذية، وهو ما أدى لشعور بعدم اللامبالاة تجاه أدلة متزايدة على الظلم الناتج عن معاقبة شعب كامل على تجاوزات قادته. وتوضح الكاتبة: لم يتخيل أحد أن تنتهك العقوبات الاقتصادية حقوق الإنسان وتصبح شكلا من أشكال الإبادة الجماعية، عندما فرضت العقوبات لأول مرة على العراق عام 1990. إذا فرضت الدول ذات الأحجام المماثلة عقوبات على بعضها البعض، كما كان الحال مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، فإن التأثير يكاد يكون رمزيا. وإذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دولة صغيرة، مثل كوبا، عندئذ يمكن للأمة المستهدفة أن تحول تجارتها إلى الكتلة السوفيتية. وبالتالي، فإن العقوبات الاقتصادية خلال الحرب الباردة لم تكن أبدا مدمرة. وكان ينظر للعقوبات على أنها "طريق وسط" بين الحرب والدبلوماسية.
وفى حالة المواجهة مع حكومة كوريا الشمالية كانت المهمة صعبة، حيث تمتلك بيونغ يانغ، روابط اقتصادية أقل مع بقية العالم، مقارنة بمعظم الدول، كما أن نظام كيم متجذر بعمق بحيث من غير المرجح أن يجبره الاضطراب الاقتصادي الداخلي على تغيير سياسته.
وقد أجبرت الجهود الأولية التي بذلتها الولايات المتحدة لقطع وصول كوريا الشمالية إلى النظام المصرفي الدولي عدة مقرضين ماليين رئيسيين فى الصين على إغلاق حسابات كوريا الشمالية، لكن منذ ذلك الحين، قامت كوريا الشمالية بتحديث استراتيجيتها بحيث غدت أقل اعتمادا على النظام المالي العالمي وأصبحت تخفى مشاركتها فيه بسهولة أكبر.
ولتتجنب كوريا الشمالية نقل الأموال عبر المقرضين الذين يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات عليهم، استخدمت شركات يصعب تتبعها خاصة في الصين لنقل النقود والسلع، ما جعل بكين، التي تحمى بيونغ يانغ سياسيا أهم شريك اقتصادي وتجارى لها، وهذا كان يعنى أن على واشنطن اللجوء لتدابير أوسع، مثل فرض عقوبات مباشرة على البنوك الصينية الكبيرة، وهو عمل من شأنه أن يؤدى إلى حدوث صدام مباشر اخطر من الواقع الحالي واحتمال لجوء بكين إلى التخلص من رصيدها من سندات الخزينة الأمريكية والدولارات بما يساوي تقريبا 2.5 تريليون دولار. في هذه الحالة كان الجانبان سيتكبدان خسائر كبيرة، وعلى ضوء الوضع الاقتصادي الأمريكي المتقلب ابتعدت واشنطن حتى الآن عن خيار التصعيد.
سجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي نموا بنسبة 6.9 في المئة في عام 2018. وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 80.2 تريليون دولار في عام 2017 إلى 85.800 تريليون دولار في 2018.
ما يقرب من نصف هذا النمو جاء من أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة، التي بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها 19.4 تريليون دولار بزيادة 5.4 في المئة عن عام 2017، والصين التي بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لها 12.2 تريليون دولار بزيادة 10 في المئة عن عام 2017.
لا تزال الولايات المتحدة تشكل أكبر اقتصاد في العالم، باقتصاد حجمه 19.4 تريليون دولار، يمثل 24.4 في المئة من الاقتصاد العالمي.
تأتي الصين في المرتبة الثانية باقتصاد حجمه 13.61 تريليون دولار يمثل 15.4 في المئة من الاقتصاد العالمي.
سلاح ذو حدين
يقول محللون في الغرب أن سياسة ترامب لتوسيع نطاق العقوبات سوف تضر بمكانة الولايات المتحدة عالميا وتحد من قدرتها.
إن اعتماد الرئيس ترامب المتزايد على العقوبات الاقتصادية لحل مشاكل السياسة الخارجية، واستغلاله قوة بلاده المالية بطريقة عشوائية، يدفع حتى حلفاء أمريكا إلى تكثيف جهودهم لحماية أنفسهم بطرق يمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى تآكل القوة الأمريكية، حسبما يحذر عدد من الخبراء الذين أدلوا بآرائهم، ومنهم لآلان رابابورت مراسل السياسة الاقتصادية، وكاتي روجرز مراسلة البيت الأبيض، في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
كيف يمكن أن يحدث هذا "التآكل في القوة الأمريكية"؟ حين تطلق الولايات المتحدة عقوباتها كالثور الهائج، فتجمد أصول الأفراد والمؤسسات والدول في كل حدب وصوب، وتطرد القريب والبعيد خارج النظام المصرفي العالمي، فإنها لا تترك مفرا من البحث عن حلول بديلة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقويض أداة رئيسة للأمن القومي، وتقليل اعتماد العالم على الدولار كعملة احتياطية عالمية، بل ربما يؤدي في مراحل بعيدة إلى انهيار النظام المالي بأكمله.
حينها سيكون المسؤول الأول عن ذلك الضعف هم الأمريكيون أنفسهم لأنهم "يفرضون عقوبات على الجميع من أجل كل شيء"، كما يقول ريتشارد نيبو، الذي يعمل الآن باحثا في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وإذا كانت أصابع الاتهام ستوجه لأحد، فالأولى بها ساكن الأبيت الأبيض الذي بات "يعتقد أن العقوبات تصلح كبديل عن السياسة الخارجية".
وإذا كان ترامب ينتظر بشغف استغاثات المعاقبين طلبا للرحمة الأمريكية، فليستمع أولا إلى ماثيو ليفيت، الذي عمل في منصب مساعد نائب وزير المالية للمخابرات والتحليل في إدارة جورج دبليو بوش، الذي ينصحه بأن "العقوبات وحدها لن تحل مشكلتك أبدا، ما لم تستخدم إلى جانب أدوات أخرى".
وليفيت، الذي يشغل الآن منصب مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يشعر بالقلق إزاء "الاعتماد المفرط على العقوبات، في غياب الأدوات التكميلية الدبلوماسية وغيرها"، ويحذر من أن هذا النهج "يمكن أن يقوض مكانة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي".
بدائل
إن الجدير بالتأمل حقا هو سعي الاتحاد الأوروبي لتطوير نظام بديل يسمح بتجاوز البنية التحتية الحالية للمعاملات الدولية. وإذا لم يكن ترامب يأبه بأعداء الولايات المتحدة، فإن حلفاء أمريكا يمكن أن يلحِقوا بها أبلغ الضرر، وما فعله الاتحاد الأوروبي حتى الآن ليس سوى غيض من فيض.
خلال عام 2019، طرح الاتحاد الأوروبي "أداة دعم التبادلات التجارية"، ويطلق عليها اختصارا اسم "إنستيكس"، كبديل لشبكة الاتصالات العالمية بين البنوك "سوفت" التي تسهل غالبية المعاملات المالية الدولية، دون التقيد بالدولار الأمريكي، وبالرغم من تعهد أوروبا بعدم استخدام هذه الأداة مع إيران، إلا لمبيعات السلع الإنسانية، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها لأنها أدركت أن وراء هذه الخطوات تكمن مخاطر مستقبيلة، وما يبدأ بـ"تحد للنهج الأمريكي تجاه إيران" قد ينتهي بأضرار كبيرة على الولايات المتحدة.
وإذا كان هذا هو صنيع الأصدقاء، فبالطبع وضع فنزويلا وكوريا الشمالية سيجعلهما ييممان وجهيهما شطر العملات المشفرة، التي يمكن استخدامها للتحايل على النظام المصرفي التقليدي، وفقا لتحذير بيتر هاريل، خبير العقوبات في "مركز الأمن الأمريكي الجديد"، والحال هكذا، ليس مستغربا أن تحول روسيا احتياطيات سيادية بمليارات الدولارات، محتجزة في البنوك الأمريكية إلى ذهب، كوسيلة للحد من التأثير المحتمل لعقوبات إضافية.
وحين لاحظ هاريل خطوات ومناهج حلفاء أمريكا وخصومها، على غير اتفاقٍ مسبَق، ورصد "علامات على أنهم يطرقون أبواب هذا النوع من الاستثمارات"، تساءل مستهجنا: "هل وصلنا الآن إلى النقطة التي سيستثمر فيها كل من الخصوم والحلفاء في هذه الأدوات التي تتيح لهم الخروج من تحت مظلة نفوذنا".
وإذا كان بيتر هاريل مصدوما مما وصل إليه الحال عند هذا الحد، فينتظر ربما تزيد الأوضاع في هذا الشأن من المخاطر إذا ما فاز ترامب بفترة رئاسة ثانية، كما يتوقع جون إي سميث، الذي كان مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة حتى العام 2019، لأن بقاء مثله في منصبه، وبالتالي استمرار سياساته العشوائية سيجبر المزيد من الدول على النجاة بنفسها من بين أنياب الولايات المتحدة، التي تنهش في جسد الحلفاء كما الخصوم، وتهدد حتى برلمانتهم بـ"فرض عقوبات لم يشهدوا مثلها من قبل".
ارقام قياسية
أظهر تقرير صدر عن شركة "جيبسون دن" القانونية إفراط ترامب في استخدام أدوات العقوبات، سواء من حيث المعدل أو النطاق، ليس فقط ضد الخصوم، ولكن أيضا ضد الحلفاء. وقد كان عام 2018 شاهد إثبات حيث وردت أقوى حجة من وزير الخزانة ستيفن منوشين الذي وصف العقوبات بأنها "بديل رائع للعمليات العسكرية"، لكنه أغفل أن إدارة ترامب أضافت حوالي 1500 من الأفراد والكيانات إلى قائمة العقوبات، أي ما يزيد بنسبة 50 في المئة عن أي عامٍ سابق، بحسب جوستين موزينيتش، نائب وزير الخزانة الأمريكي.
وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية أو فرضت عقوبات على أكثر من 2800 من الأفراد والكيانات والسفن والطائرات منذ تنصيب دونالد ترامب، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالعقوبات التي فرضت في عهد سابقيه، وفي عام 2018 فقط استخدمت إدارة ترامب هذا النهج بوتيرة تفوق ما فعلته أمريكا خلال الـ15 عاما السابقة.
تكلفة مدمرة
جاء في تقرير أنجزه دوغ باندو الكاتب السياسي الأمريكي الباحث بمعهد كاتوا للدراسات:
إن معاقبة ما يعرف في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بـ "المواطنين المحددة أسماؤهم بصفة خاصة" و"الأشخاص المحظورين" أصبحت عادة منتظمة تمارسها واشنطن. وقد بلغ عدد هؤلاء الأشخاص ثمانية آلاف في سنة 2019. وقد لاحظت مجلة "الإيكونومست" أن إدارة ترامب وحدها أضافت 3100 اسما خلال السنوات الثلاث الأولى، أي أنها أضافت عددا يقارب العدد الذي ضمنه جورج دبليو بوش خلال ثماني سنوات. أما اليوم، تتضمن قائمة المستهدفين 1358 صفحة.
حتى الحلفاء والأصدقاء، وبالأخص أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والهند، معرضون للتهديد باستخدام الحرب الاقتصادية ما لم يقبلوا بأولويات واشنطن
لكن هذه العملية خرجت عن السيطرة، إذ يبدو أن الاستجابة الأولية لصناع السياسة فيما يتعلق بشخص ما أو منظمة بعينها أو حكومة تقوم بارتكاب أمر لا يوافقون عليه، أصبحت تتمثل في فرض العقوبات. لسوء الحظ، إن الاعتماد على الحرب الاقتصادية والعقوبات تعتبر وفقا للتقاليد المتعارف عليها تصرفا حربيا، قد أدى إلى تضخيم الطموحات الجيوسياسية للمسؤولين الأمريكيين إلى حد كبير.
حاليا يتدخل كبار المسؤولين الأمريكيين في أصغر التفاصيل الجدلية الأجنبية. وحتى الحلفاء والأصدقاء، وبالأخص أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والهند، معرضون للتهديد باستخدام الحرب الاقتصادية ما لم يقبلوا بأولويات واشنطن التي تخدم مصالحها الذاتية وأوهامها الذهنية.
ينطبق الأمر نفسه على العقوبات المطبقة على الأفراد والشركات والكيانات الأخرى. وغالبا ما يتعرض المستهدفون للأذى، ويستحق معظمهم ذلك لكنهم عادة ما يحافظون على نفس السلوك أو يحل أشخاص آخرون محلهم. من هو الديكتاتور المخلوع، وما هي السياسة التي وقع تغييرها، وما هو التهديد الذي وقعت مواجهته، وما هو الخطأ الذي وقع تصحيحه كنتيجة للحرب الاقتصادية؟ في الواقع، هناك القليل من الأدلة على أن العقوبات الأمريكية تحقق الكثير من أي شيء بخلاف تشجيع المثالية الأخلاقية الزائفة.
وكما ذكرت مجلة ذي إيكونوميست، "إذا لم يغيروا السلوك، من الممكن أن تصبح العقوبات شكلا من أشكال العقوبة باهظة الثمن والتعسفية إلى حد ما بدلا من كونها أداة للإكراه". تمثل هذه العقوبات أداة قد تنقلب في يوم من الأيام ضد الأمريكيين. وعلى عكس الافتراضات الواضحة في واشنطن، ليس من السهل أن تتحلى البلدان بصفات الولايات المتحدة، حيث أن النزعة القومية الأولية تنتصر عادة. يجب على الأمريكيين التفكير في كيفية ردهم للفعل إذا عكس الوضع. لا يريد أحد الامتثال لإملاءات أجنبية لا تحظى بشعبية.
كثيرا ما تؤدي الحرب الاقتصادية إلى تفاقم الصراعات الأساسية. فبدلا من التفاوض مع واشنطن من موقف ضعف، هددت إيران حركة النقل البحري في الخليج العربي وأغلقت صادرات النفط السعودية وسلطت المنتسبين إليها والقوات غير النظامية على القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها. من جهة أخرى، تحدت روسيا أولويات متعددة لسياسة واشنطن، وسلمت كوبا السلطة إلى جيل ما بعد الثورة ووسعت نطاق أعمالها التجارية الخاصة بما أن سياسات إدارة ترامب أعاقت النمو وقوضت جهود رواد الأعمال.
لكن التوسع اللانهائي للعقوبات من شأنه أن يؤثر بدوره على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ويعد اتباع القواعد مكلفا، وانتهاك قاعدة واحدة حتى عن غير قصد سيكون مكلفا أكثر من ذلك. في هذا الصدد، تمتنع شركات شاري بشكل استباقي عن تنفيذ الأعمال القانونية في عملية تسمى "إلغاء المخاطرة". كما أن حركة الأعمال الإنسانية تعاني أيضا. من يريد المخاطرة بخطأ باهظ في التعامل مع المعاملات ذات القيمة المنخفضة نسبيا؟ قد لا تزعج هذه الآثار صانعي السياسة الأمريكيين المتعجرفين، ولكن من المؤكد أنها تثقل كاهلنا.
واشنطن وحدت معظم العالم ضدها
لعل الأهم من ذلك أن اعتماد واشنطن المفرط على العقوبات الثانوية مسؤول عن بناء مقاومة للهيمنة المالية الأمريكية. من جهته، حذر وزير المالية الأمريكي جاكوب ليو في سنة 2016 من أنه "كلما أكدنا على التزام استخدام الدولار ونظامنا المالي بالسياسة الخارجية الأمريكية، زادت مخاطر التوجه إلى العملات الأخرى والأنظمة المالية الأخرى على المدى المتوسط".
في الواقع، لن يكون التخلي عن الدولار العظيم سهلا. مع ذلك، إن محاولات الولايات المتحدة المتعجرفة لتنظيم الكرة الأرضية قد وحدت معظم العالم ضدها. وحسب المحامي الشهير بروس زاجاريس، تعمل واشنطن عن غير قصد على حشد الدول والمنظمات الدولية بما في ذلك الحلفاء الأمريكيين لتطوير طرق للتحايل على العقوبات الأمريكية.
في هذا السياق، عطلت السفن التجارية وناقلات النفط أجهزة الإرسال والاستقبال، ونقلت السفن بضائعها في البحر. كما رتبت الشركات صفقات نقد ومقايضة، وساعدت القوى الكبرى مثل الصين على الانتهاك والتحريض وتحدت واشنطن بتحطيم علاقات اقتصادية ثنائية أكبر بكثير. وأقر الاتحاد الأوروبي "حظر التشريعات" للسماح باسترداد الأضرار الناجمة عن العقوبات الأمريكية والحد من امتثال الأوروبيين لهذه القواعد. وطور الاتحاد الأوروبي أيضا مقايضة تعرف باسم "آلية دعم التبادل التجاري"، وذلك للسماح بالتجارة مع إيران دون الاعتماد على مؤسسة مالية أمريكية.
من جهة أخرى، ركزت روسيا على تقليص حجم المدفوعات الدولية وعملت مع الصين لتسوية التجارة الثنائية باستخدام الروبل الروسي والرنمينبي الصيني. وزادت البنوك المركزية الأجنبية مشترياتها من الذهب. وفي القمة الإسلامية الأخيرة، اقترحت ماليزيا استخدام الذهب والمقايضة في التجارة لإحباط العقوبات المستقبلية، بينما بيع الذهب في فنزويلا باليورو.
حتى الآن، لا تهدد هذه التدابير الدور المالي السائد لأمريكا ولكنها تنبئ بالتغييرات المحتملة في المستقبل. قد يتسبب هجوم واشنطن على خطط ألمانيا لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا في شيء أكبر من ذلك بكثير. ولا تعد برلين مجرد ضحية عرضية لسياسة الولايات المتحدة، بل هدفا لهذه السياسات. من جهته، عبر وزير الخارجية هايكو ماس عن قلقه قائلا: "يجب أن تُقرر سياسة الطاقة الأوروبية في أوروبا، وليس في الولايات المتحدة". للأسف، يفكر الكونغرس بشكل مختلف.
مع ذلك، يعد الأوروبيون أقل استعدادا لقبول هذا النوع من السخط، نظرا لأن واشنطن تعاقب حتى الحلفاء المقربين دون أي هدف واضح سوى إظهار قوتها. في حالة نورد ستريم 2، من المحتمل أن تكمل شركة غازبروم المشروع إذا لزم الأمر. حيال هذا الشأن، قال نائب وزير الخارجية الألماني نيلز أنين إن "أوروبا تحتاج إلى أدوات جديدة لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها من العقوبات الفظيعة التي تتجاوز الحدود الإقليمية".
لا يمكن إنكار الدور الذي تلعبه العقوبات التجارية في السياسة الخارجية، لكن الحرب الاقتصادية هي في نهاية المطاف حرب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب صراعات حقيقية. فكر في استجابة الإمبراطورية اليابانية لقرار إدارة روزفلت بقطع صادرات النفط. يمكن أن تقتل الحرب الاقتصادية الأبرياء.
كتب المحلل الاقتصادي ليندون هيرميل لاروش جونيور وهو سياسي، وناشط سياسي أمريكي في 20 مايو 2005 أي قبل 15 سنة:
إن عملية التحول الجذري الجارية منذ أربعة عقود، وهي المدة التي هجر فيها الاقتصاد العالمي على نحو متنام الصناعات واتجه بكل قوته إلى المضاربات غير المقيدة، قد وصلت إلى طريق مسدود. إن النظام المالي العالمي علي وشك الانفجار داخليا. إن الناتج الإجمالي العالمي الذي يقدر بحوالي 40 تريليون دولار سنويا يحمل على كاهله فقاعة هائلة من المضاربات أكبر بمرات عديدة من حجمه، حيث تبلغ هذه الفقاعة حوالي 2000 تريليون دولار من التداولات المالية سنويا. إن الإفلاس الوشيك للعديد من الشريكات الأمريكية ما هو إلا عامل واحد من العوامل العديدة التي قد تقود إلى انهيار النظام المالي العالمي".
عمر نجيب

.jpg)
.jpg)
.gif)








.jpg)