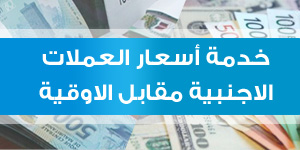تمثل الثقافة بطاقة تعريف حضارية تتحدد بها الهوية وتتحصن بها الكينونة الذاتية للمجتمعات إذا ما أرادت أن تدخل في تلاقح وتثاقف حضاري مثمر وبناء مع غيرها، وبقدرما كانت الثقافة أصيلة وضاربة الجذور في تقاليد المجتمع وأعرافه بقدرما أظهرت كفاءة فائقة على اقتناص العناصر التي تعزز وجودها واستقلالها وتحافظ بالتالي على ملامح وجوه أهلها وسنحاتهم في عملية التلاقح
ويمكن القول إن الثقافة العربية – التي هي مدار حديثنا في هذه السطور – ظلت في عهودها القديمة مثالا حسنا في هذا الصدد؛ إذ كانت مرآة تعكس حياة الإنسان العربي، وآلامه، وآماله، ونظرته للأشياء، وفلسفته في الحياة مهما كانت اللحظة الحضارية التي تكتنفه؛ فمن يقرأ شعر امرئ القيس أو النابغة أو زهير مترجما إلى أي لغة من لغات الدنيا سيجد ذلك الإنسان العربي الذي عاش في الجزيزة العربية قبل البعثة المحمدية بقرابة قرن ونصف؛ سيجد التصورات... الهموم... الأفراح... الأتراح... باختصار سيلفي شخصية عربية تنبض بالحياة...، وبالمثل من يقرأ لشعراء العهد الإسلامي سيجد مثل الإسلام وقيمه وروحه تسري مع كل كلمة وتكاد تخرج من تحت كل حرف ممتزجة – بطبيعة الحال – مع الروح العربية بكل ما فيها من كرم وشهامة وإباء...، وشيء مماثل يمكن أن يقال عن العهود اللاحقة
غير أن هذا لا يمنع من ملاحظة أن هناك إبدالا ثقافيا حدث لهذه الثقافة منذ أخريات العصر الأموي لا يخلو من الخطورة ليس على الوجود الأنتولوجي للذات الحضارية، وإنما على مستوى كفاءة هذه الذات في المضي قدما لمواصلة مشوارها الحضاري على النحو الصحيح؛ هذا الإبدال جاء نتيجة لمجموعة من العوامل منها ما هو خارجي، ومنها ما هو داخلي
1 – الخارجي: نستطيع القول بأنه تمثل في بعدين: بعد اجتماعي، وبعد ثقافي
1 – 1 – البعد الاجتماعي: من الملاحظ أنه مع الفتوحات الإسلامية الكبيرة التي أحرزها المسلمون في العهد الراشدي وتمددت رقعتها في العهد الأموي دخلت أفواج هائلة من مختلف الأجناس البشرية تحت ظل الدولة الإسلامية وامتزجوا بالجنس العربي، وكان هذا الكم البشري الهائل – بطبيعة الحال – له عاداته وتقاليده ونظرته للحياة الغريبة على المجتمع المضيف، والمختلفة والمتباينة فيما بينها؛ مما شكل صدمة للوعي العربي فبدأ يصوغ خطابه الثقافي في ضوء معطيات هذا المجتمع الهجين، طبعا كان بإمكان العقيدة الإسلامية أن تخلق نوعا من التناغم والانسجام في مجتمع كهذا لو كان يصدر عنها بشكل مخلص، ولكن هيهات. فالعصبية والتكالب على المصالح والابتعاد عن منهج الإسلام وطريقه... كل ذلك كان هو سيد الموقف
1– 2 – البعد الثقافي: في أواخر العهد الأموي والحقبة الأولى من العصر العباسي نشطت الترجمة من لغات مختلفة إلى اللغة العربية في شتى مجالات المعرفة، وكان هذا جيدا – لا شك في ذلك – فقد أعطى نتائج طيبة وساهم في بلورة نهضة علمية احتلت الريادة على المستوى العالمي حينها، بيد أنه – إلى جانب ذلك – ساق معه أنماطا أخلاقية وحمولات أيديولوجية أثرت في "النموذج القيمي" العربي الإسلامي وجعلته يمشي – أحيانا – وكأنه يترنح وما مثال أبي نواس عنا ببعيد
تجدر الإشارة إلى أن هذين البعدين الاجتماعي والثقافي كان بإمكانهما أن يكونا مصدر ثراء وخصوبة للثقافة العربية لو وجدا بيتها الداخلي مرتبا كما يجب أن يكون، ولكنهما وجداه متناثرا ومبعثرا، ووجداها ملقاة على سرير متهالك في ركن منه قد أنهكها المرض فكانا مصدر تخمة لها
ولا أظن أن القارئ الكريم إلا يدرك معي أن كل التيارات الضالة والنزعات المنحرفة التي عرفها الإسلام عبر تاريخه الطويل كل ذلك ما هو إلا تجل واضح لهذه التخمة الفكرية التي ضربت الثقافة العربية في هذه الفترة المبكرة من تاريخها، والتي ظلت تتفاقم يوما بعد؛ بسب خلخلة وهشاشة "النواة الثقافية" للعرب والمسلمين خاصة فيما بعد العهد الراشدي
وإذا كان هذا عن العوامل الخارجية التي كانت لها يد في هذا الإبدال الثقافي الذي ألمحنا إليه فإن هناك عوامل داخلية كان لها دورها الذي لا يقل أهمية
2 – الداخلي: يمكن اعتبار فتنة عثمان بن عفان رضي الله التي أودت بحياته بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير – كما يقال – فقد تمخضت عن الحركة السبئية اليهودية التي نفثت سمومها بين المسلمين بأفكارها المنحرفة المارقة التي تستهدف تقويض الإسلام من الداخل بإشاعة الفوضى ونشر الأقاويل المغرضة والكاذبة؛ مما أدى إلى الإجهاز على عهد من العدل والتسامح والمساواة والشورى... من الصعب أن يوجد له نظير في التاريخ
ولم تكن الحركة السبئية – وحدها – هي من أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه فقد كان هناك نفوذ الزعامات القبلية التي دخلت الإسلام بدون أن تتشرب مبادئه ومثله وأخلاقه وتعاليمه على النحو الصحيح، كما كانت هناك التحولات الاجتماعية الكبيرة والتدفق الهائل للأموال مع ضعف في أجهزة الدولة وعدم توفر القدرة اللازمة في التسيير...
لقد كان عثمان رضي الله عنه ذا مكانة رفيعة في الإسلام وأسبقية لا يجادل فيها أحد، ولكنه كان في تلك الفترة قد تقدمت به السن ولانت عريكته، ومن ثم كان يؤثر أسلوب الرفق واللين والمسالمة على الأخذ بالحزم والصرامة كما كان سلفه عمر بن الخطاب يفعل؛ مما جعل الدهماء والمشاغبين وأصحاب النوايا السيئة يجترئون عليه ولا يرهبون جانبه
ومن الواجب علي أن أنبه – هنا – إلى أن عثمان رضي الله عنه – على عكس الصورة النمطية المعروفة عنه – كان زاهدا في الدنيا فقد كان في أيام خلافته ينام في المسجد النبوي على حصير رث، وكان – وهو الخليفة – يصعد المنبر وعليه قميص مرقع، ويروى أنه مات وليس لديه من المال إلا راحلتين (جملين للركوب) مع أنه – كما هو معروف – كان صاحب ثروة عظيمة قبل وصوله إلى الخلافة
إذن كانت فتنة عثمان بداية لأزمة سياسية وعسكرية جثمت على صدر الدولة الإسلامية لعصور لاحقة، ولم يكن وصول الأمويين إلى الحكم إنهاء لتلك الأزمة وإن بدا أنه كذلك؛ فالأزمة باقية تتفاعل بأشكال مختلفة وما أحزاب الزبيريين والخوارج والشيعة... وتحركاتهم المناوئة إلا هزات ارتدادية لها
لقد أثرت هذه الأزمة على "النواة الثقافية" ودفعت بها إلى مضامين مأزومة، ومحمولات مشوهة كانت وراء بلورة أنساق خبيثة "فيرست الثقافة" وأضرت بالمجتمع وحولته من دائرة الفعل إلى منطقة اللافعل من خلال سلسلة من المفاهيم والقيم المغلوطة التي لا يمكن أن تتقدم بالأمة خطوة إلى الأمام في سبيل فعل حضاري إيجابي ومثمر...
ولعل ملامح هذه الأنساق سوف يتاح لي توصيفها في مقال قادم
الشيخ ولد باباه اليدالي

.jpg)
.jpg)
.gif)







.jpg)