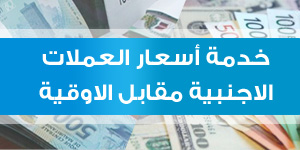لقد أصبحنا على أبواب الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو المقبل. إنها فرصة لأن يقبل الجميع، في الموالاة كما في المعارضة، أنهم على متن نفس المركب، إن جنح ـ لا قدر الله ـ سيخسر الجميع، و إن وصل إلى بر الأمان فالكل سيربح.
و الواقع أن الرهان الأساسي لسَاسَتِنَا من شتى الانتماءات هو "القبطان" الذي سيقود المركب، و ليس المهم عندهم وضعية المركب نفسه. بيد أنه في أي نظام جمهوري، تعتبر المؤسسات الضامن الرئيسي لاستقرار و ديمومة الدولة و ليس الأفراد، مهما كانت قيمتهم و أهميتهم. بالنسبة لنا، فإننا لا نعير البعد المؤسسي أهمية كبيرة. خلال الحوارات التي نظمت منذ 2011 إلى 2016 و التي شارك فيها ممثلون عن الأغلبية و جزء من المعارضة، التي أطلق عليها المعارضة المحاورة، فإن إصلاح المؤسسات السيادية، أي العدالة و الإدارة و مؤسسات الأمن و الدفاع، لم تكن نقطة جوهرية. لقد تم التطرق باستحياء لضرورة حياد الإدارة و الجيش في الانتخابات، دون اقتراحات ملموسة أو نظرة استشرافية.
بعد قرابة ستة عقود من عمر الدولة الموريتانية، انتقلنا خلالها من نظام مدني ذي حزب أحادي إلى سلسلة من الأنظمة العسكرية أو أنظمة سائرة في طريق الدمقرطة يقودها عسكريون وصلوا إلى السلطة بالقوة و ذلك منذ 10 يوليو 1978 و حتى الآن، باستثناء فترة الرئيس الأسبق سيد محمد ولد الشيح عبد الله، الذي كان مدعوما هو الآخر من طرف عسكريين نافذين، تبدو مؤسساتنا الجمهورية اليوم متقادمة و تنتمي إلى زمن آخر. فلكي تقوم بدورها على الوجه المطلوب، تحتاج إلى إصلاح و تحيين لتستطيع مواكبة تطور شعبنا و طموحاته الديمقراطية المشروعة.
صحيح أن كل إصلاح جاد و موضوعي يتطلب الإرادة و الصبر. فمؤسسات قوية و ذات صدقية هي الدرع الوحيد الذي يستطيع تأمين بلدنا من الزوابع و التغييرات غير الدستورية و التي تُرْجِعُ دوما إلى الصفر عداد مكتسباتنا على طريق الدمقرطة. فلتفادي هذه الدوامة السيزيفية و العبثية يجب أن تنصب جهودنا، من الآن فصاعدا، على إدخال إصلاحات فعلية على المؤسسات التي تعتبر ركائز الدولة، حتى ولو تطلب منا ذلك سنوات عديدة.
فعلينا أن نستلهم من تجارب الدول التي عرفت مسارا مشابها لمسارنا، و بالأخص في إفريقيا و أمريكا اللاتينية، و حتى في شبه الجزيرة الإبيرية. لقد عرف بلدنا أربعة انقلابات "ناجحة": 1978 ، 1984 ، 2005 و 2008 ؛ كما عرف حوالي عشر محاولات انقلابية، منها اثنتان دمويتان: 16 مارس 1981 و 8 ـ 9 يونيو 2003 ، مع ما انجر عن ذلك من ضحايا و تصفيات، و مظالم و إقالات انتقامية و تجاوزات و فساد و عقوبات خارج القانون.
لقد قدم انقلاب 2005 فرصة ذهبية للطبقة السياسية حينها لفرض إصلاحات جوهرية في مؤسسات الدولة قبل تنظيم أي اقتراع، خصوصا أن أعضاء المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطية قد تعهدوا بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. إلا أن قصر نظر و سلامة طوية نفس الطبقة السياسية جعلاها تعتقد أن تنظيم اقتراع يكفي لحل كافة مشاكل البلد، و هو ما اتضح بعد ذلك أنه وهم كبير.
تكرر نفس الخطأ بعد التغيير غير الدستوري الذي تم سنة 2008 حيث قبلت المعارضة، في خضم اتفاق دكار الذي أبرم في اللحظات الأخيرة، بالمشاركة في انتخابات كانت ستحظى باعتراف الجميع لو تم تحضير المؤسسات السيادية لتنظيمها بشكل أفضل. كان ذلك التحضير، لو قيم به قبل تنظيم تلك الانتخابات، سيمكن من تفادي جو عدم الثقة و سوء التفاهم الذي ساد بين جزء من المعارضة، الذي يطلق عليه المعارضة الراديكالية و الذي طبع العشرية 2009 ـ 2019.
فالفرصة التي تمت إضاعتها سنة 2005 و 2008 تتكرر اليوم مع مغادرة الرئيس بعد إكماله للمأموريتين اللتين يخولهما له الدستور. فاحترام القانون الأساسي من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، المنتخب سنة 2009 و المعاد انتخابه سنة 2014، يعتبر فعلا يستحق الإشادة و يشكل سابقة في التاريخ السياسي لبلدنا. إنها أيضا الفرصة التي يتعين اغتنماها لإدخال تعديلات عميقة بمشاركة الجميع على المؤسسات السيادية للدولة.
فبخصوص الإدارة، يجب أن تتمحور هذه الإصلاحات، من بين أمور أخرى، على تحيين النصوص التي تنظم مسابقات الاكتتاب و التحويلات و ترقية الوكلاء و الموظفين و تمهين القطاع الإداري، إلخ. كذلك يتحتم أن يهتم هذا الإصلاح بالتحسين الملموس للظروف الحياتية للإداريين، مع لزوم الحياد السياسي للعاملين منهم.
أما بخصوص مؤسسات الدفاع و الأمن، فإن الإصلاحات المقترحة عليها يجب أن تنصب على مراجعة القوانين و النظم التي تحكم مهمة و السير الداخلي للجيش و الصنوف الأخرى: الدرك، الحرس، الشرطة ، مكتب الدراسات و التوثيق، أمن الطرق، الحماية المدنية، إلخ.، و ذلك لضمان أن يكون تسيير هذه المؤسسات شفافا، مع قابلية التحقق من ذلك. في هذا الإطار، يجب إصلاح العدالة العسكرية و إعادة الاعتبار لها بغية السماح للمتقاضين بالتوجه إليها بسهولة، دون إكراهات أو عوائق. كما يجب إنشاء هيئات و آليات لرقابة ميزانيات هذه الصنوف المختلفة، و ذلك على مستوى القطاعات الوزارية و الكيانات الإدارية الوصية من أجل متابعة أفضل و للتحقق من تسيير هذه الحسابات و تقديم كل شخص يثبت ضلوعه في عملية اختلاس للمال العام، مهما تكن رتبته أو وظيفته.
ثم إن هذا الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف الحياتية لأفراد القوات المسلحة و الأمن، و بالأخص إقرار زيادة معتبرة في رواتبهم لتتناسب مع الرُّتَبِ و ليس مع الوظائف. كذلك يجب أن يكون بمقدور الجمعية الوطنية القيام بأي تحقيق داخل أي صنف لإطلاع الرأي العام الوطني على الحالات المحتملة من ظلم و فساد و اختلاس داخل هذه المؤسسات. يجب أيضا أن يكون الأفراد العاملون من هذه المؤسسات غير معنيين بالعمل السياسي كي يتمكنوا من القيام بمهامهم التي ينص عليها الدستور و القوانين و النظم المعمول بها أو تلك التي ستنبثق عن الإصلاح المذكور.
في هذا الإطار، لا يكفي سن قوانين تحظر و تجرم بشدة الانقلابات، بل يجب، و هذا هو الأهم، إيجاد حلول نهائية للمشاكل التي قد تكون الأسباب الحقيقية لأي تذمر أو تغيير غير دستوري. هكذا فإن الاكتتابات و الترقيات و التحويلات و التعيينات في مختلف المناصب و المهام يجب أن تتم وفق معايير محددة سلفا، عادلة، موضوعية، شفافة و يمكن للجميع الاطلاع عليها.
أما بخصوص العدالة، فيجب أن تكون مستقلة و منفصلة فعليا عن السلطة التنفيذية. لذا فإن الإصلاح المنشود يجب أن يكرس، من بين أمور أخرى، الفصل الفعلي بين السلطات بتعيين رئيس المحكمة العليا أو أي مسؤول هيئة قضائية عليا كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء. لا بد لأي إصلاح للقضاء أن يهتم بتحسين الظروف المادية للقضاة و كتاب الضبط و كافة العاملين بهذا القطاع حتى يكون باستطاعتهم القيام بمهامهم بعدل و حياد. ثم إنه يتحتم تحديث التكوين الأساسي و المستمر للقضاة و كتاب الضبط حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطور الحاصل في المنظومة القضائية على مستوى العالم، لأن القضاء لا يقتصر فقط على بعده المحلي، بل له أبعاد أخرى إقليمية و دولية و متقاضون آخرون محتملون و من مختلف الجنسيات و الثقافات و المعتقدات. فهذا التكوين يجب أن يمكن القاضي و كاتب الضبط من اكتساب ثقافة قانونية عصرية و علمية، مع ضرورة أن يكونا ملمين إلماما حقيقيا بلغة أجنبية أخرى، كالفرنسية أو الإنجليزية، إلى جانب اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلد و اللغات الوطنية الأخرى: البولارية و السوننكية و الوولفية.
ثم إن إصلاح التعليم و الحكامة الرشيدة و أي قضية ذات بعد وطني يجب أن يكون موضوع أيام تشاورية وطنية تشارك فيها القوى السياسية و المجتمع المدني و النقابات و الخبراء و المفكرون و الشخصيات المرجعية لتتم مناقشتها بنضج و تتجسد في خارطة طريق واقعية و قابلة للتطبيق.
بيد أن هذه الإصلاحات لا يمكن القيام بها إلا من طرف حكومة موسعة يتم تشكيلها لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، في نهايتها، و بعد إكمال هذه الإصلاحات، يمكن تنظيم انتخابات حرة و شفافة.
هذه الحكومة الموسعة أو حكومة وحدة وطنية، لا عبرة بالتسميات، يجب أن تُشَكَّل من طرف الأحزاب و الفاعلين السياسيين المشاركين في انتخابات 22 يونيو بصيغ يتم التوافق عليها، مهما تكن النتائج النهائية لهذه الاستحقاقات.
فيكفي أن نعي المصلحة العامة و ننتبه للأخطار المحدقة بالبلد، الواقع في منطقة اضطراب سياسي ـ أمني جد خطيرة، أي منطقة الشريط الساحلي ـ الصحراوي، لنفهم أهمية مثل هذه الإصلاحات و طابعها الاستعجالي.
إن ذلك هو الحل الأنسب، حسب اعتقادنا، الذي يسمح لنا بتعزيز مكاسبنا على درب الدمقرطة و يجنبنا أزمات ما بعد الانتخابات و عدم الاستقرار السياسي الذي قد ينجم عن ذلك.
د. أحمد ولد المصطف

.jpg)
.jpg)
.gif)








.jpg)