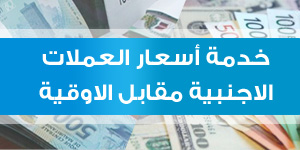{إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (هود / 88)
***
لا يزال النقاش العام في موريتانيا حبيس مصطلحات مستهلكة عاجزة عن ترجمة الرهانات المصيرية التي ستحدد مستقبل البلاد. فالخيارات السياسية المتوفرة جمدتها منذ فترة طويلة المواجهة العقيمة بين المعارضة والنظام الحاكم وأبعدتها عن المشاغل الأساسية للمواطنين. لهذا السبب، يعتبر تجديد العرض السياسي المطروح حاليا أولوية قصوى لتشجيع انخراط الشعب وخصوصا الشباب في إطار رؤية تحمل الأمل. ولهذا الغرض، يهدف هذا النداء إلى جمع الموريتانيين حول مشروع مجتمعي ينأى عن التجاذبات التي عطلت المسار السياسي طيلة العقود الماضية ويترفع على الاعتبارات الشخصية والأطروحات الإديولوجية التي طالما احتكرت اهتمام الفاعلين، لمعالجة التطلعات الملحة للموريتانيين والقضايا الأساسية التي تحدد مستقبلهم.
وهدف هذه المبادرة في نفس الوقت هو إعادة الاعتبار للنضال والالتزام السياسي من ناحية والقطيعة مع الثنائية العقيمة التي تتجاذب النخبة والتي تتجسد في الخيار بين التواطئ أو الاستقالة من الشأن العام. كما تشدد على تجردها من أي حسابات ضيقة أو انتماء حزبي، حيث لا يسعى أصحابها لأن يتم إشراكهم في إدارة التغييرات المقترحة بقدر ما يأملون أن يتبنى الشباب الفكرة الكامنة من ورائها. فالهدف هو المساهمة في إحداث تغيير جذري يشرك الشباب في صياغة عقد اجتماعي جديد يعكس تطلّعات وأولويات الشعب الموريتاني بكل أطيافه.
هذا النداء موجه لجميع أصحاب النوايا الحسنة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والاجتماعية، وهو يسعى ليكون مبادرة بناءة تنظر نحو المستقبل وآماله لا نحو الماضي وأخطائه. وخلافا للنزعات الشعبوية، يستند النداء إلى القناعة بأن التطور والنمو إنما هما نتاج تراكم الجهود التي بذلت من طرف الحكومات المتعاقبة وليس إنجاز قائد ملهم وحيد. ومع الاعتراف بمساهمة كل من شارك في مسيرة البناء الوطني إلا أن هذه المبادرة تندرج في إطار قطيعة واضحة مع الممارسات الموروثة من الماضي (على غرار الفساد والزبونية والمحاصصة القبلية والعرقية والجهوية) التي تقف حاجزا أمام آفاق التطور والتقدم.
بصفة أدق، تنادي هذه المبادرة بتجديد المشهد السياسي من خلال إعادة النقاش السياسي إلى أرضية الأفكار بعيدا عن الجدل الإيديولوجي والصراعات الشخصية، وهي ترتكز على تشخيص للوضع العام وللتحديات التي تواجهها البلاد، لوضع رؤية إستراتيجية للتغيير تقترح السبل الكفيلة برفع هذه التحديات.
بلد في أزمة، مجتمع في تحول
بعد مضي ستة عقود على استقلالها، لا زالت موريتانيا عاجزة عن تحقيق وعود الازدهار والتنمية. صحيح أنها قطعت أشوطا هامة في سبيل بناء الدولة وذلك بالرغم من العقبات التي واجهتها (ومن بينها التصحر وتأثير التغيرات البيئية على الاقتصاد الوطني ونزاع الصحراء والاضطرابات السياسية المزمنة...)، إلا أن المشروع الوطني لم يكتمل بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب رؤية بعيدة المدى تركز على الأولويات الأساسية واعتماد، بدلا من ذلك، مقاربات تنموية همها الأساسي إرضاء اللوبيات والمتنفذين وكذلك الارتجال في تحديد أولويات الاستثمار، أوقع البلد في الركود وحرمه من اغتنام فرص التنمية وجني ثمارها، كما أن استشراء الفساد والرشوة كمنهج لتسيير الشؤون العامة وشخصنة السلطة وانتشار الممارسات الاستبدادية وضعف حكم القانون والمؤسسات مع انتهازية النخب، كل ذلك قوض مصداقية الدولة والطبقة السياسية.
هذا الوضع أدى إلى تقهقر البلاد مقارنة بجوارها المباشر شمال وجنوب الصحراء. فبالنسبة للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، لا تزال موريتانيا في أسفل الترتيب الدولي في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، كما يعاني الاقتصاد الوطني من ضعف القدرة التنافسية وارتفاع التبعية للخارج، إذ لا يوفر إلا جزءاً بسيطا من احتياجات البلاد الغذائية والصناعية،حيث يبقى الاقتصاد قائما على تصدير المواد الخام مع قيمة مضافة ضعيفة وقدرة تشغيلية محدودة.
من ناحية أخرى، تعيش البلاد اليوم على وقع تحولات اجتماعية تحمل مخاطر جسيمة يمكن أن تعصف باستقرارها وترهن مستقبلها، نذكر من بينها:
1. أزمة نموذج الحكم الموروث عن الفترة الاستعمارية وما بعد الاستقلال والقائم على المحاصصة وتوزيع المنافع على الوجهاء والمقربين من السلطة وقد استنفذت هذه المنظومة إمكانياتها في إدارة المشهد، خاصة مع ارتفاع سقف التطلعات الشعبية والنمو التدريجي للوعي السياسي على نحو جعل هذه الأدوات التقليدية لتنظيم الحياة السياسية غير ناجعة، خاصة في ظل تقلّص نفوذ الوجهاء والأعيان.
2. التطور السريع لمستوى الوعي واليقظة لدى الرأي العام، لا سيّما في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، التي ساعدت على تعميم قيم المواطنة وازدياد المطالبات بالتغيير وهو ما يفرض نهجا سياسيا جديدا للتفاعل معها في المرحلة القادمة.
3. تآكل التماسك الاجتماعي تحت التأثير المشترك للعوامل التالية:تلاشي آليات التضامن الاجتماعي التقليدية دون أن تحل محلها آليات بديلة، مما أدى إلى اتساع رقعة المُهمشين الفاقدين لكل أمل بالنسبة للمستقبل والذين ليس لهم ما يخسرون.
- تصاعد الأصوات المنادية إلى الانزواء والانغلاق وراء هويات إثنية وقبلية ضيقة على نحو بدأ يؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي ويقوض عملية بناء هوية وطنية جامعة كما يصرف الاهتمام عن الأولويات التنموية الحقيقية.
- إغراءات الهجرة، لا سيّما لدى الشباب وحاملي الشهادات ذوي المستوى التعليمي العالي، نظرا لانعدام آفاق واعدة لمستقبل أفضل في البلد، مما يغذي تنامي ظاهرة هجرة الأدمغة وما تمثله من نزيف للموارد البشرية للبلاد.
- مخاطر انتشار التطرف العنيف كردة فعل "عدمية" على التهميش الاجتماعي والإحساس بالظلم وضعف التمسك بالثوابت الوطنية والدينية في مواجهة تأثيرات العولمة وتمس بالأساس الشباب المحبط في ظلّ ضعف الجهود المبذولة في سبيل التوزيع العادل للثروة الوطنية وإشراك الأجيال الصاعدة في الشّأن الوطني. وتشكل هذه الظاهرة خطرا واضحا على استقرار البلاد بما يترتب عنها من عواقب تنموية وخيمة، نظرا للأولوية الممنوحة للأمن في مواجهة هذه الظاهرة، على حساب التنمية.
إن تظافر هذه التحولات الاجتماعية يضع البلاد في مواجهة إشكاليات مصيرية من بينها:
أ. أزمة حوكمة:
يعاني المجتمع الموريتاني من أزمة أخلاقية عميقة في ظل تفكك القيم التقليدية، التي حلت محلها قيم بديلة تستند إلى المادية الجامحة وحُمى الاستهلاك والسّعي وراء الثراء بشتى الطرق وقد أدى هذا الوضع إلى إفلاس الإدارة والمرافق العامة التي قوضها الفساد وغياب المحاسبة ويكفي هنا الاستشهاد بتعميم ممارسات مثل الرشوة للحصول على الرخص الادارية والصفقات العامة ومقابل الاستفادة من تخفيضات ضريبية أو جمركية، مما بات شائعا في كواليس الحكومة... كما يتجلى ذلك من خلال تكوين البعض لثروات هائلة في ظرف وجيز، عن طريق استغلال النفوذ وكذلك خوصصة أجزاء معتبرة من الأملاك العامة لفائدة دائرة المقربين من السلطة. وقد شهدت هذه الظاهرة تفاقما خلال السنوات الأخيرة، مع تكاثر الصفقات المشبوهة في تجاهل تام لمتطلبات القانون والقواعد التي تضبط الصفقات العمومية وفي غياب كلي للمحاسبة وذلك في تناقض صارخ مع الشعارات التي كان يرفعها النظام. ويبدو أن الأمر وصل حتى إلى استقالة الدولة من مسؤوليتها الرقابية لحماية المواطنين وممتلكاتهم، حيث تركت المجال مفتوحا أمام المغامرات المالية، خالقة بذلك وضعا على غاية من التعقيد، قد يهدد السلم الاجتماعي. مثل هذه الممارسات لها أثر كارثي على التنمية نظرا لانعكاسها على الطبقات الأكثر فقرا وهشاشة وعلى القطاعات المنتجة التي تخضع لضغط جبائي متزايد.
ب. ارتفاع مستوى البطالة والهشاشة الاجتماعية:
لا يزال الاقتصاد الموريتاني يواجه تحدي البطالة التي تصل إلى مستويات قياسية جعلت البلاد تحتل المراتب الأولى على الصعيد الدولي. وفي غياب في إرادة سياسية واضحة وطموحة للتشغيل، تبقى فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي حكرا على القطاعات غير المنتجة، مما لا يُمكِن من خلق مواطن عمل جديدة تحد من البطالة التي يعاني منها الشباب بالأساس. كما يواجه الاقتصاد تحدي خلق قيمة مضافة، خاصة من خلال تحويل الموارد الطبيعية التي يتم تصديرها بشكل خام، تزيد من الدخل الوطني. كما أن الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الدولة لتكوين وتعليم الأجيال المتعاقبة لم يرافقها تفكير استشرافي يساعد سوق العمل في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، مما أدّى إلى ضعف التخصص وعدم ملاءمة فرص التكوين الصارخ لاحتياجات السوق، حيث يتم إهمال الشُعب والاختصاصات التقنية إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، تمنع القيود والحواجز الإدارية والإجرائية والسياسات الضريبية غير المدروسة العواقب القطاع الخاص من العمل في بيئة ملائمة تسمح له بتقديم مساهمة أكبر في التنمية والتشغيل. في هذه الظروف، لا يمكن التنبّؤ بالآثار الاجتماعية الوخيمة المترتبة على مثل هذا المستوى من البطالة، حيث تعجز آليات التضامن التقليدية عن احتوائها في ظلّ تزايد مظاهر الهشاشة الاجتماعية وذلك بالرغم من التراجع المفترض لنسبة الفقر في البلاد.
ج. فشل النظام التربوي:
يعاني قطاع التعليم من نقاط ضعف هيكليّة، بما فيها (1) انخفاض معدل استكمال المرحلة الابتدائية؛ (2) ضعف جودة التعليم التي تمّ إهمالها لصالح مقاربة تقوم على زيادة أعداد التلاميذ مع إهمال النوعية. ولا يمكن اعتبار إنشاء شعب امتياز تستوعب عددا محدودا من المحظوظين كافيا لتسويغ إهمال جودة التعليم بأكملها، هذا ولم تعد المؤسسة التعليمية تلعب دورها في التربية المدنية وفي ترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. وعلى الرغم من الارتفاع الهام في نسبة التمدرس خلال العقود الأخيرة ومن تخصيص ميزانية معتبرة للقطاع، فإن التعليم لا يزال يعاني من حالة تسيب عامة تتجلى في معدلات نجاح متدنية، خاصة على مستوى امتحان البكالوريا (أقل من 10٪)، حيث تبقى الغالبية العظمى من الطلاب على الهامش وتضطر للبحث عن وظائف بسيطة لضمان لقمة العيش. من ناحية أخرى، يظهر اختلال صارخ بين التكوين المقدم من جهة واحتياجات الاقتصاد وسوق العمل من جهة أخرى، مما يزيد من نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
د. تهميش الشباب وتضييق آفاقهم:
يعتبر المجتمع الموريتاني مجتمعا فتيا إذ يمثل الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة أكثر من نصف السكان (57.1 ٪) ومع ذلك فهم يشعرون أنهم ضحيّة تهميش متعدّد الأوجه تزيد من حدته التفاوتات الاجتماعية والتمييز على أساس الجنس، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على فرص عمل لائقة. وهكذا يواجه عدد كبير من الشباب شبح البطالة (كما يتبين من خلال العدد القياسي للمشاركين في المسابقات للحصول على أبسط الوظائف) أو يضطر للعمل في ظروف صعبة لا تضمن آفاقا للتنمية الشخصية وللارتقاء المهني. بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من الدراسات الميدانية إلى أن الشباب أصبح يعاني من الارتباك نتيجة لفقدان الثوابت والمرجعيات، حيث أضحى ممزقا بين القيم التقليدية لمجتمع محافظ وإغراءات الحداثة، في ظلّ غياب شبه كامل لوسائل الترفيه وفرص التنمية الثقافية والاجتماعية. وعلى صعيد آخر لا يزال إشراك الشباب في الشأن العام ضعيفاً للغاية، نظرا إلى استبعاده إلى حد كبير من صنع القرار والمشاركة في تحديد الأولويات التنموية. ويساهم انعدام آفاق للاندماج الاقتصادي وضعف الثقة في المؤسسات الشعور باليأس، الذي يعاني منه الشباب، مما يشجع الكثير على خوض تجربة الهجرة أو سلوك طريق التطرف العنيف. ومما يزيد هذا الإحساس عدم وجود رؤية أو سياسة وطنية طموحة للشباب تهدف إلى تلبية طموحاتهم والاستجابة لتطلعاتهم وإشراكهم في عمليّة البناء الوطني.
هـ. هشاشة التماسك الاجتماعي:
لا يزال مستوى الشعور الوطني والالتزام والمشاركة في الشأن العام متدنيا جدا نتيجة لعوامل مختلفة مثل ضعف الدولة ومحدودية قدرتها على تلبية تطلعات المواطنين وتراكم المظالم التاريخية وتهميش فئات كبيرة من السكان.
وتعتبر هذه الوضعية نتيجة طبيعية لتجاهل الأنظمة المتعاقبة للمواطنين، الذي وصل أحيانا حد الازدراء، مما أضعف لدى هؤلاء الفخر بالانتماء للبلد. كما يعاني المجتمع من شعور شرائح اجتماعية واسعة بالتمييز، الذي يغذّي مطالب متكررة لتقاسم السلطة على أساس عرقي أو إثني نتيجة للغبن والتهميش. إضافة إلى ذلك، يساهم بقاء مشاكل ونزاعات قديمة ومظالم تاريخية بدون حل في تقويض البناء الوطني الهش أصلا. فلا يزال إرث العبودية، على وجه الخصوص، تحدياً جسيما بالنسبة للتماسك الاجتماعي، حيث يمثل استمرار ممارسات الاسترقاق التي يحميها المجتمع بشكل أو بآخر، وإن تقلص عددها وقلت حدتها تدريجيا، تهديداً حقيقياً لوحدة البلاد وللسلم الاجتماعي. ويصاحب هذه الممارسات أيضًا تهميش واضح لشريحة الحراطين في غياب تقدم ملموس في ظروفهم المعيشية أو استجابة كافية ترقي إلى مستوى تطلعاتهم للاستفادة من فرص للعيش كريم.
إحياء الأمل
تمتلك موريتانيا العديد من الفرص التي يمكن أن تمثل، إذا استغلت بحكمة، نقاط قوّة لتسريع وتيرة التنمية، من بينها: الأراضي الشاسعة ووفرة الموارد الطبيعية، الدينامية الديموغرافية القوية ونسبة الشباب المرتفعة، العقيدة الدينية المشتركة، التعددية الثقافية، التكامل بين المناطق المختلفة ووجود جالية خارج البلد غنية بالكفاءات والمهارات التي يمكن تسخيرها لخدمة البلد. وتمثل هذه العوامل الأسس التي يمكن الاستناد عليه لبناء المستقبل. ومع ذلك، فإن إعادة موريتانيا إلى مسار البناء يتطلّب وضوحا في الرؤية لفهم ومواجهة التحديات، إضافة إلى كثير من التفاؤل وإرادة قوية لإيجاد حلول تؤدي إلى تغييرات سريعة تلبي طموحات الشعب. ولهذه الغاية، فإننا نقترح من خلال هذا النداء جملة من الأولويات والإصلاحات لإحياء الأمل ووضع أساس لمشروع قائم على العودة إلى القيم الأخلاقية والقطيعة النهائية مع ممارسات الماضي عبر المحاور التالية:
1. وضع المواطن في صميم الأولويات وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاته الأساسية: وهو ما يتطلب الإنصات إلى اهتمامات الناس والتفاعل معها. لقد نسي قادتنا لوقت طويل أن واجبهم الأول وأساس مشروعيتهم الوحيد هو الإصغاء إلى مواطنيهم وحل مشاكلهم وعليه فيتعين على الحكومة أن تتصرف بحيث يشعر المواطن أن الإدارة والمؤسسات موجودة ومسخرة لخدمته، كما يفترض وضع خطط وآليات كفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مرافق عمومية جيدة وتعليم حديث ونظام صحي شامل وتوفير الماء والكهرباء لكافة السكان. ويتعين على الدولة التأكيد على دورها الذي لا غنى عنه في إعادة توزيع الثروة الوطنية من خلال إنشاء آليات فعالة للتضامن الاجتماعي (بما في ذلك توسيع نظام التأمين الصحي القائم) ووضع برامج فعالة لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية تركز على الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة (بما يشمل سكان الأرياف الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والتغيرات البيئية وسكان أحياء الصفيح الذين يعيشون في الفقر المدقع). كما ينبغي التركيز بشكل خاص على تحسين السكن في الضواحي المحرومة على أطراف المدن الكبرى.
2. الاستثمار في الشباب والتجاوب مع تطلعاته: من واجب الدولة توفير حلول ملائمة لمواجهة الإحباط المتنامي لدى الشباب وشعوره بالإقصاء. ولهذه الغاية، فإن صياغة رؤية وخطة شاملة للشباب بحلول سنة 2030 ستساعد على استعادة ثقة هذه الشريحة وإشراكها في عملية البناء الوطني. وسيسهم ذلك في خلق بيئة مؤاتية لتنشئة شباب مبادر ومتشبع بالثوابت الوطنية وبقيم المواطنة، قائم بشؤونه وملتزم اجتماعيا. ويتوجب على المدى القصير منح الأولوية لإنشاء آليات لتشغيل الشباب وتطوير المواهب والكفاءات، بالإضافة إلى خلق فضاءات للمشاركة وتعزيز المواطنة.
3. استعادة حيادية المؤسسات ومصداقيتها من خلال إعادة التركيز على الأخلاقيات والضوابط التي تحكم الحياة السياسية والفضاء العام، وتفعيل دولة القانون التي تحترم وترعى الحقوق من خلال عدالة مستقلة وقريبة من المواطن وهيئات رقابية فعالة لحماية البلاد من الاستبداد وسوء استغلال السّلطة. كما أنه من الضروري التركيز بوجه خاص على آليات مكافحة الفساد نظراً لتأثير هذه الظاهرة المباشر على الظروف المعيشية للسكان، خاصة الفئات الأكثر فقرا. ويجب على الدولة أن تسهر على علوية المصلحة العامة على أي مصالح أو اعتبارات أخرى. إن استعادة الدولة لرسالتها كضامن وراع للمصلحة العامة سيساعد في استعادة المواطن لثقته في المؤسسات ولكرامته واعتزازه بالانتماء إلى الوطن، كما سيساهم في إبعاد المواطنين عن الانتماءات الفرعية والتمسك بالهوية الجامعة، مما يسهل بناء المستقبل المشترك.
4. تعزيز التماسك الاجتماعي: إن ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد، بغض النظر عن انتماءاتهم الفردية، من صميم المهام الموكولة للدولة. ويستوجب تحقيق هذا الهدف إدراك وتقدير الطابع المتعدد الثقافات والأعراق للبلد (بما في ذلك بالنسبة للنفاذ إلى الفرص الاقتصادية ولتقلد الوظائف العمومية، مع التمسك بمعايير الكفاءة)، بما من شأنه أن يعكس التنوع بشكل أفضل ويخلق بيئة تسمح لجميع المواطنين بالتمتع بكل حقوقهم دون استثناء أو تمييز. وعليه، فان الحل الأمثل والأوحد يكمن في خيار الدولة الحاضنة، حيث تضمن حقوق الجميع ويتحدد فيها مكان ودور الفرد حسب قدراته الذاتية وجدارته، دون اعتبار أصله أو عرقه أو ثقافته أو مكانته الاجتماعية. وفي هذا السياق، وخلافًا للأطروحات التي تدافع عنها بعض الجهات السياسية المنزوية على ذاتها، نود هنا التأكيد على أن مسألة الهويّات وضرورة احترامها وتنميتها تدخل، في ظل النظام الديمقراطي، تحت طائلة السياسة الثقافية أكثر مما تتعلق بتوزيع السلطة أو إدارة الدولة.
ويتطلب تعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص، توفير كل الوسائل المطلوبة لوضع حد فوري لجميع أشكال الاستعباد وممارساته، دون أي نوع من التغاضي، كشرط لا غنا عنه ومهما كان ثمنه لإصلاح هذا الظلم التاريخي والقضاء على مخلفاته أو رواسبه المتبقية وذلك لمنع استمرار الظاهرة بأشكال وأساليب جديدة قد تعرض النسيج الاجتماعي الهش لهزات لا يمكن له تحملها. كما يجب أن تكون المعركة ضد الرق ورواسبه أولوية وطنية بامتياز وذلك من خلال تخصيص موارد كافية من ميزانية الدولة لإحداث نقلة نوعية قادرة على تعبئة المجتمع بأكمله حول نهج جديد يبتعد عن الجدل ويسمح بوضع حلول عملية ملائمة لهذه المسألة المستعصية. وفي نفس السياق، ينبغي التركيز، من بين الأولويات العاجلة، على إعادة تأهيل وإشراك شريحة الحراطين في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك عن طريق آليات التمييز الإيجابي، نظرا إلى تأثير هذه المسألة على التماسك الاجتماعي. كما يتعين على الدولة أن تقدم حلولا نهائية وحاسمة للمظالم الإنسانية العالقة، من خلال الحوار ومع مراعاة حقوق الضحايا وذويهم وضمانها.
5. وضع سياسة فعّالة للتشغيل تستفيد من الفرص الاقتصادية القائمة، من خلال توفير حوافز للقطاع الخاص وانتهاج سياسة طموحة على مستوى القطاع العام، بما في ذلك إطلاق مشاريع كبرى لتعزيز البنية التحتية للبلاد، مما سيسمح بمواجهة البطالة. ويجب على وجه الخصوص التركيز على استغلال فرص النمو في القطاعات الواعدة (المعادن، الصيد البحري، الزراعة والتنمية الحيوانية، السياحة، الخ) لخلق مواطن شغل تساعد في امتصاص البطالة.
***
إدراكا منا لحالة البلد المزرية وللحاجة الماسة لإيجاد مخرج سريع، فإننا ندعو من هذا المنبر إلى تجديد الطبقة السياسية وخطابها ليكون متناغما مع مشاغل وتطلعات المواطنين وخاصة الأجيال الناشئة. لطالما كانت الحياة السياسية رهينة جدل عقيم وخلافات شخصية لا داعي منها ولطالما فُقدت القدرة على صياغة وتنفيذ مشاريع جِدّية تمكن من التحول الاجتماعي بسبب انتهازية النخبة الساعية وراء مصالحها الضيقة واستقالتها وخوفها من التغيير، تحت ذريعة التشبث بالاستقرار.
هذا الوضع يقتضي توجيه نداء إلى ضمير المواطنين من أصحاب النوايا الحسنة والغيورين على مصلحة البلد، للانخراط في مشروع من شأنه أن يُحي الأمل في صدور الناس ويضع البلد على طريق السلامة ويساهم في تكوين طبقة سياسية جديدة مؤهلة لفهم تطلعات المواطنين والذود عنها. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا ندعو كل من يرى نفسه منسجما مع الخطوط العريضة لهذا النداء أن ينضم إلينا لرسم معالم مشروع مشترك لبناء موريتانيا الغد، بعيدًا عن إعادة إنتاج الوصفات القديمة والنخب المستهلكة والمزايدات السياسية التي أظهرت فشلها على مرٍ العقود المنصرمة.
وفي هذا الظرف الدقيق وبينما تتأهب البلاد لانتخابات رئاسية حاسمة في غضون بضعة أشهر، فإن الأولوية الآن للتعبئة والتسجيل على اللوائح الانتخابية لقطع الطريق أمام تواصل نهج الحكم الموروث من الماضي والذي يعني الإبقاء على الفساد واستمرار الوضع على حاله من ظلم وغبن واستبداد.
3 مارس 2019
عبد الرحمن اليسع، موظف دولي
محمد المنير، موظف دولي

.jpg)
.jpg)
.gif)








.jpg)