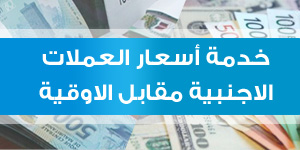هل من تعايش أكثر إيلاما و طردا في الواقع المعيش من تعايش التخلف و وهم التحضر، و الفقر و الحرمان مع الغنى بالموارد و حسن المواقع الإستراتيجية على ضفة نهر و عند مصبه و شاطئ على المحيط الأطلسي أغنى العالمين بالسمك و فيه الغاز و البترول، و الماضوية السلبية مع وهم التفتح و نبذ التفاوت الطبقي، و من وجود طبقة متعلمة بمقاييس العصر مع تخلفها المضمخ بالارتكاس النفسي عن الأداء في الميدان التطبيقي و تقمصها كل سقطات الرجعية و الأرستقراطية التسلطية بقوتي الحرف المدجن و الحربة الطائشة المتجاوزين على خلفيات مكينة من النرجسية التي تحمل عقد الخواء و علامات النفاق و التملق و حب المال السهل لإبقاء قانون التباين و الفوارق؟
موريتانيا إلى أين؟ موضوع ندوة قيمة نظمها في نواكشوط المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية. و إذ تناولت الندوة ـ و قد رأى البعض أن عنوانها مبتذل و مستهلك يسعى في بعض مراميه الغرضية التي تخلو من البراءة و الوطنية إلى التشكيك المطلق بوجود البلد القابل للبقاء ـ أوجها متعددة لهذا السؤال الكبير، فإنها استطاعت أن تحدد كذلك ملامح هامة لتجلياته من خلال عرضين و إن كانا أكاديميين بامتياز فقد كانا موجزين و مركزين. و أما أولهما فتناول بالعناوين العريضة الكاشفة من خلال منهجية اتسمت بالحياد البحثي و استندت على التقارير العلمية المدعمة بالأرقام و الإحصاءات و قراءة المنحنيات و الاتجاهات و القياسات و المؤشرات الوردة من الجهات ذات الاختصاص و المصداقية العالمية و الأممية، في حين كان المشغل الثاني قد تناول الجانب السياسي و المراحل و التحولات الكبرى التي طبعت عمر الدولة المركزية المولودة من رحم الاستعمار سنة 1960 و لم تكن قبل كيانا ينعم بمركزية القرار في حيز ترابي له حدود مرسومة معلومة.
و إذ كان القاسم المشترك بين العرضين، بغض النظر عن أنهما مبحثان متكاملان، هو الجانب الاجتماعي الذي شكل المحور و المنطلق و الأرضية التي جرى عليها التناول، فإن المشغل الأول أبان بلغة التقارير المدعمة بالأرقام و المشفوعة بالاستنتاجات الكارتيزية عن وضعية ظلت مختلة منذ النشأة بعدما أثرت فيها عوامل جفاف اسمر أزيد من
ثلاثة عقود متتالية و حرب ضروس لم تكن البلاد على قدر خوضها و انقلابات عسكرية أدخلتها في دوامة من عدم الاستقرار لتقطع دابر كل سياسة تنموية و إصلاح مجتمعي هيكلي من أشد ما ظلت تعاني من فساده و ظلمه و تقويضه لأي سعي إلى دولة القانون و العدالة، وضع قوامه دولة المواطنة التي لا تستحي من تصحيح أخطاء الماضي لضمان استقامة الحاضر و تامين العبور إلى المستقبل المتوازن. و اتضح من خلال هذا المبحث الذي توخى الحياد في ظل ظروف سياسية هي في حقيقتها أسوأ من الحالة التنموية العاثرة، بل و إنها على ما هي عليه من ضعف الخطاب و غياب البرامج و ارتباط بالقبلية و الإثنية و الشرائحية من أسباب ديمومتها. فكل المؤشرات المتعلقة بالموارد الطبيعية تبين أن استغلالها على غير ما يخدم بناء الوطن و بعيد عن منهج تحسين أوضاع المواطنين و تعليهم و تكوينهن و إسناد مهمة البناء لهم،مما يتجلى في:
· تدني التعليم و استمرار إشكاليته المحيرة التي لا تجد الحلول إلى الإصلاح،
· ضعف التغطية الصحية في ظل انعدام الكفاءات و الوسائل و البنى التحتية، فيما هو حاصل منها توجه إلى القطاع الخصوصي الذي لا يعني عموم الشعب،
· غياب الصناعة في أبجدياتها لصالح استيراد مهول لكل الحاجيات من لدن قلة ميسورة لدى اليد الطولى على المال و الدولة و الجاه،
و أما المشغل الثاني فكان قراءة موضوعية في واقع اجتماعي و سياسي لم يعرف يوما التوجه الصحيح إلى المعادلة البناءة التي نريد مجتمعا متصالحا مع نفسه و مشاريع سياسية مطلقة مع الماضوية السلبية و متجهة إلى المستقبل الواعد. و هو المشغل الذي أبرز أنه لا منهج سياسي قويما متبع حيث الساحة تعيش على وقع مزيج من تعارض النوايا و غياب الخطاب و احتجاب الرؤية بسبب ضبابية المشهد، و قد قدم في مختتم حوصلة من نماذج الأحكام بخلفيات أيديولوجية مختلفة منها الديني و الرأسمالي و الإشتراكي التي تتطرح نفسها لأنقاذ البلد من حالة التوجه إلى التلاشي دون أن يكون ثمة ذكر للنموذج العسكري الذي هو خيار يفرض نفسه بالقوة على الشعوب الضعيفة ذات النظم الاجتماعية الطالمة بطبقيتها و ذات النخب الخائرة الممسكة بتلابيب الخلفيات الماضوية الحية، و إذا ما كانت الاستمرارية في ظله مضمونة العواقب.
و لما كانت المداخلات من بعض حضور نخبوي كبير، لم يستطع أكثر من ثلثيه البقاء حتى النهاية، فقد صبت جلها في ذات النسق من الأخذ على المسار السياسي و التنموي و الاجتماعي للبلد و على جل نخبه في عجزها عن لعب الأدوار المنوطة بها لتغيير عقليات المجتمع و قد ظلت عالقة مابين أحضان ماضي اجتماعي تطبعه "التراتبيبة" و يسوده منطق الغبن و التباين و التفاوت أمام فرص الحياة من منطلق و من موازين قوة غاشمة لم يؤثر فيها الإسلام السمح و لا ميلاد الدولة المركزية و لا حتى الالتحام بمفاهيم الإنسانية الجديدة إلا قليلا رغم مرور أزيد من ستة و ستين عاما من هذا الاستقلال.
و إنه بهذا كله للوضع الراهن القائم الذي ما زال يرمي بكل ثقله على حركة تنموية و اقتصادية لا تكاد تحمل اسم مسار و لا تعبر عن حقيقة بلد غني بالموارد الطبيعية المتنوعة لساكنة تمثل فيها:
· نسبة الشباب الطاقة الحية أزيد من ستين بالمائة،
· و الفقر الذي يفقأ العيون ظاهرة مرضية نسبة تفوق التسعين بالمائة،
· و التخلف النشاز في بلد غني نسبة تجاور المائة،
· و الهوة السحيقة بين القلة المتخمة بالمال السهل من النهب و النصب و الاحتيال و الكثرة التي تفوق الخمسة و التسعين بالمائة في حضيض الفقر و الجهل و المرض.

.jpg)
.jpg)
.gif)








.jpg)