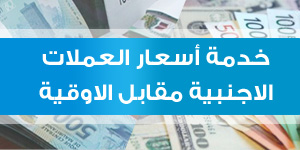كملايين المصريين كنت في لحظة ليست بعيدة ألوح بعلم بلادي في الهواء، وكنت أحتفل في الشارع كما لم أحتفل في حياتي من قبل. كنت في الغربة في هذه الأيام، وكانت الجالية المصرية كلها تملأ شوارع العاصمة هتافا وغناءا، تحيطها أعدادا هائلة من الجاليات العربية وبعض الأوروبيين. الكل كان يحتفل بالمسمار الجديد الذي دق في نعش الديكتاتورية، وكنا نحن نجوم الحفل.
الفخر كلمة قليلة لوصف الشعور الذي كان يملأ قلبي في هذه الأيام. كلما جلست مع أصدقائي المصريين في مقهى أو مطعم، كان صاحب المطعم والعاملين يأتون للحديث معنا وهم ينظرون إلينا بإعجاب واضح. في لحظة شعرت – أو شعرنا، إذا ما جاز لي أن أتحدث بلسان سائر أبناء الجالية – إننا ننتمي إلى أقوى وأعظم وأعرق شعوب الدنيا.
عدت إلى مصر خلال بضعة شهور بعد التنحي. كنت أنتظر بفارغ الصبر أن أجد الفرصة لكي أساهم في إعادة بناء بلدي، سواء من خلال حملات التوعية أو من خلال إعادة هيكلة مؤسسة القضاء التي أعمل بها.
لكن شيئا من ذلك لم يحدث. تبددت آمالي سرابا، مع ثقافة الفوضى والجعجعة وعدم القدرة على العمل الجماعي من جهة، ومن جهة أخرى مع البيروقراطية والعقم الإداري المعهود. تحولت آمالي الواسعة في خلال أشهر قليلة إلى مجموعة متتالية من الصدمات. لا داعي لذكر أسباب هذه الصدمات، فكلنا يذكر ما مرت به هذه البلاد من أحداث، أغلبها للأسف على أيدي أبناءها. لكن ضف إلى هذه الأزمات العامة، ما مررت به شخصيا من خلال تجربتي في الإشراف على الانتخابات. رأيت جهلا يفوق الوصف، رأيت ألوف مؤلفة يسوقها الفلول والإخوان إلى صناديق الانتخاب كما تساق الأنعام في سيارات النقل، مقابل علبة سمنة أو زجاجة زيت. هذه المشاهد القاسية كانت كفيلة لتحطم ما تبقى في نفسي من الرومانسية الوطنية .
ثم زادت عليها بعد زادت ما استجد – أو ما ظهر واستفحل بمعنى أدق – من تصرفات المصريين في الحياة اليومية بعد الثورة، وأعتقد أيضا أني بغنى عن الاستفاضة في نوعية هذه التصرفات. كان طبيعي بعد كل هذه الجرعة المكثفة من الإحباطات أني تخلصت إلى غير رجعة من عقدة الفوقية المصرية. من الساذج أن ترى شعبا يبيع بلده ومستقبل أولاده في الانتخابات مقابل علبة سمنة، ثم تدعي إنه يتمتع "بوعي سياسي بالفطرة". وعندما تتعرض يوميا لعمليات غش وخداع في البيع والشراء والخدمات، ثم تدعي أننا شعب يفوق بضميره سائر الأمم، فإنك تصبح مثارا للسخرية. عندما تتصدر بلدك قائمة دول العالم في التحرش الجنسي، وتصبح شوارعنا مباحة للسير في جميع الاتجاهات، وتعجز أن تقضي مصلحة واحدة دون أن تدفع رشوة أو تقوم باتصالاتك الشخصية، ويصبح الفن لدينا هو أفلام السبكي وأغاني أوكا وأورتيجا، ونعجز حتى عن الوقوف مثل باقي خلق الله في طابور...ثم تأتي سيادتك بكل زهو وثقة لكي تعاير أبناء الأمم الأخرى بإننا قد سبقناهم إلى الحضارة بخمسة آلاف عام، فإنك تصبح مثيرا للشفقة.
شعرة أو شعرات قليلة حالت بيني وبين اليأس التام. مجموعة صغيرة من شباب المتطوعين في القاهرة استقطعوا من وقتهم وجهدهم لإقامة مشاريع تنموية في الأرياف. مجموعة أخرى أكبر منها تسافر دوريا إلى بني سويف والفيوم لعلاج المرضى بالمجان. رغبة صادقة في التعلم – التعلم من أجل التعلم - لمستها في بعض الطلبة، عندما أتيحت لي الفرصة للتدريس بالجامعة. عم جمال الترزي الذي يشتري كل صباح علب السردين ليطعمها إلى القطة البلدي التي ولدت حديثا أمام باب محله. عم عبد الفتاح، البقال الكفيف الذي يستقبلك بابتسامة عريضة وهو يغلق المصحف المكتوب بخط براين، ويسألك بحسن نية كاملة عن قيمة الورقة التي ناولته إياها ليعيد إليك الباقي. هذه المجموعة اللطيفة من الشباب النشط الذي يلتقي صباح كل جمعة ليمارسوا معا رياضة العجل، متحدين مخاطر الشارع المصري المعتادة ومضايقات المارة.
هذه المشاهد القليلة التي قد تبدو طبيعية في أي مجتمع، تكون في ظل الوحل البشري الذي نعيشه في مصر، أشبه بمعجزات صغيرة. معجزات تبدو محيرة في بداية الأمر، ثم تذكرك بشيء بديهي يغيب عن ذهننا من قسوة الواقع الذي نعايشه يوميا. إن الإنسان هو الإنسان في أي مكان وفي أي مجتمع...مهما وصل به التخلف والهمجية في حقبة من الزمن، مازال هو ابن آدم الذي كرمه الله تعالي عن سائر المخلوقات. هو ذلك الكائن الذي لم يقنط منه الله يوما وأمره بألا يقنط يوما من رحمته مهما أخطأ. نعم، مصر في مرحلة لعلها تكون من أسوأ مراحل تاريخها أخلاقيا وحضاريا وعلميا....مجتمعنا اقترب من قاع العالم في الفوضى وسوء السلوك...لكن تظل تلك البذور الطيبة الجميلة، هذه القلة القليلة في وسط حقول شاسعة من الأشواك...تظل تنتظر من يسقيها لتنمو وتطرح وتغطي على ما حولها من الزرع الشيطاني..هذه البذور الطيبة التي لم ولن تعدم يوما في أي مجتمع من بني البشر. الألمان الذين استقبلوا اللاجئين السوريين بالطعام والورود منذ بضعة أسابيع...أليسوا هم أبناء وأحفاد جيل كامل كان يدعم سفاحا قتل عشرات الملايين ؟ ألم تصنع أمريكا حضارتها على أكتاف رعاة البقر ؟ والأكثر من ذلك، ألم تنزل رسالة الإسلام على قوم من البدو الأميين فصنعت منهم في غضون قرن من الزمان حضارة من أعظم حضارات التاريخ؟
هذه البذور الطيبة القليلة هي الشيء الوحيد الذي يعيد إليً الطاقة إذا ما تساءلت يوما عن جدوى عملي كقاضي أو كمحاضر في هذا البلد. نعم المصريون ليسوا رواد العالم العربي ولا ملوك أفريقيا ولا ملوك المجموعة الشمسية...لكني كلما تذكرت هذه اللقطات، أيقنت أن البذور الطيبة لن تختفي يوما من أهل بلدي، كما لم ولن تزول أبداًمن أيموطأ لابن آدم. اسقيها يوما بعد يوم، عاما بعد عام...بلا كلل أو ملل...حتى يأذن لها الله أن تنشر ثمارها الطيبة في كل مكان.

.jpg)
.jpg)
.gif)








.jpg)