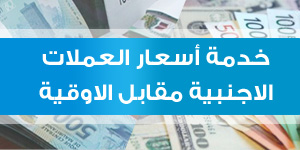يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما أنت بأحرص على هذا الوطن مني، وما أردت بسؤالي هذا الاستفزاز ولا التهويل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن المسؤولية تقتضي التفريق بين التمني والتحليل. ولقد حملني الاشفاق على هذا الوطن، وخوفي من هيبة الموقف، على الاحجام عن طرح هذا السؤال سنين عددا، برغم إلحاحه على ذهني، حتى ضقت به ذرعا، وآثرت منه تخلصا، فقررت ما ترى، وليفعل الله بي يشاء، كما قال سعد ابن أبي وقاص، في موقف غير هذا.
وما أريد أن أوصلك إلى جواب عرفته سلفا، أو أقودك إلى كمين أعددته مسبقا، ولكني أردت أن نشترك معا في مناقشة مسألة نراها جديرة بالمناقشة، وكان حريا بها أن تكون المبادرة إلى طرحها من أحد مفكرينا أو مثقفينا، لا من "متحصرم" لا يدعي لنفسه "التزبب" فالأرض ما أقفرت، ولا صوح نبتها، حتى يرعى الهشيم.
ولكن لابد مما ليس منه بد، ولكل قبلة هو موليها، فلنستبق الخيرات.
ولا أريد لأشرعة المناقشات أن تدفع مركب الموضوع إلى موانئ السياسة، تجريحا لهذا النظام، أو تبجيلا لذاك. فذلك يخرج المسألة عن سياقها الفكري، ويفرغها من محتواها العلمي. لكننا نريد مناقشات حاديها العلم، وسبيلها الصدق، وهدفها أن تمثل مجسات كمجسات الزلازل، نستكشف من خلالها ما ينتظر هذا المجتمع ودولته الفتية.
ولكن للبعض أن يسأل، وهو محق في سؤاله: لماذا هذا السؤال الاستفزازي عن مصير دولتنا، ونحن شعب يتمتع بانسجام ديني نادر (مسلم، سني، مالكي بنسبة 100%)، ويتربع على ثروات طبيعية، تمكنه من العيش الكريم، إذا ما أحسنت نخبه الحاكمة استغلالها؟.
تلك مقومات عليها المعول في الأمل الذي نتمسك به، ولكنها لن تصرفنا عن مخاطر جدية، تهدد كيان هذه الدولة الوليدة، التي كان ليوبول سدار سينغور، يرى أن مستقبلها غير مضمون، حسب ما ورد في مذكرات مؤسسها، المختار بن داداه.
وستقتصر مساهمتنا في الإجابة على سؤالنا الثقيل، في الإشارة إلى أهم هذه المخاطر، تاركين لمثقفينا، الخوض فيما وراء الأفق، والتنبؤ بما سيكون عليه هذا المنكب البرزخي، بعد عقود أو قرون.
وأول هذه المخاطر، في نظرنا، هو التاريخ. إنه عدو دولتنا الأول. ذلك أنه يعلمنا أن هذه المنطقة لفاظة للدول، وأن هذا الشعب عصي على التنظيم المركزي.
فعلى مدى ما يقرب من 1000 سنة، لم تلتئم هذه المنطقة تحت سلطة مركزية، حتى أرخى ليل الاستعمار الفرنسي سدوله. بل إنه، لولا رغبتنا في تجنب جدال تاريخي، يصرف النقاش عن مقصده، لقلنا إن تلك وضعية هذه المنطقة، منذ 2000 سنة على الأقل، برغم ما أشار إليه ابن خلدون، وغيره من المؤرخين، من قيام مملكة كبيرة لصنهاجة، مساحتها "مسيرة ثلاثة أشهر في ثلاثة أشهر".
لكن ملاحظة ابن خلدون ومن معه، غير جديرة بالتقدير، لطابع المبالغة فيها، ولأن أصحابها لا يكادون يتجاوزونها إلى غيرها من التفاصيل، التي يمكن أن تدعم هشاشتها. ولعل هذا ما حدا بالمؤرخ الهندي ابانكار، إلى تجاهل أي ذكر لهذه المملكة المزعومة، عند تناوله للامبراطوريات التي نشأت في غرب إفريقيا، في كتابه: الوثنية والإسلام في غرب افريقيا.
وحتى دولة المرابطين، التي بدأ تأسيسها في موريتانيا، انهار شطرها الموريتاني خلال جيل واحد، ولم يصلب عودها، ويستقم أمرها، إلا بعد أن هاجرت إلى المغرب، حيث وجدت رحما حضانة للدول، وشعبا أسهل انقيادا إلى التنظيم المركزي.
وإذا ما عرفنا أن المجتمعات مثل الأفراد، لها منطقة لا وعي، تؤثر في سلوكها، كما يقول المفكر المغربي الجابري، فسنتمكن من تفسير قدر كبير من سلوك نخبنا، الذي ينافي المواطنة، ويهدد الدولة.
ذلك أن الفرد في مجتمعنا، قبلي منذ أكثر من 2000 سنة على الأقل، لكنه لم يصبح موريتانيا إلا منذ 56 سنة..! ومن هنا، فكل ما يتصل بالدولة "أسيگه" في نظره: الوظيفة "أسيگه"، والأقربون من أبناء القبيلة أولى بالمعروف. المال العام "أسيگه" وخذ من شبابك، لهرمك ومن تعيينك لعزلك.
ولا يبدو لنا الحديث عن تغيير العلم، الذي تربى جيلان على حبه، باعتباره رمزا للدولة الموريتانية الجديدة، إلا أمرا نشازا، يتجاهل المصاعب التي تواجهها عملية ترسيخ فكرة الدولة، بدل القبيلة في أذهان الموريتانيين.
الخطر الثاني على دولتنا، هو الإخفاق التنموي. فبعد 56 سنة من الاستقلال، مازال مستوى الفقر في بلادنا مرتفعا بشكل مخجل. ف 42% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، حسب المسح الحكومي 2008.
أما مستوى الفقر في الوسط الريفي، فيرتفع إلى 59.4%. وفي ولايات تكانت، وكوركل ولبراكنه، يرتفع مستوى الفقر إلى أكثر من 60%. كما أن ما يقرب من نصف السكان، لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب، ولا يستخدمون إلا المصابيح اليدوية.
ولا تتجاوز نسبة التمدرس في التعليم الثانوي 30%، مما يعكس مستوى التسرب، وحجم فشل النظام التعليمي، الذي زاد من خطره، فوضى المناهج المدرسية، التي تخلق أجيالا متباينة ومتنافرة، بل وحتى متناحرة.
وهذا الإخفاق التنموي الذي يولد الشعور بالحرمان، يشكل خطرا جديا على البلاد. ذلك أن الفاصل بين الإنسان والثورة، كما يقول المختصون، هو مسافة ثلاث وجبات، إذا فقدها الإنسان غضب، وإذا غضب ثار، وإذا ثار عمت الفوضى.
ومن نتائج هذا الإخفاق التنموي، استفحال قوة الاستقطاب الأثني، والشرائحي، الذي بدأ يلقي بتوتراته، على سطح الأحداث في مجتمعنا.
ولا يقولن أحد إن 56 سنة ليست شيئا يذكر في تاريخ الدول والشعوب. فالتاريخ الاقتصادي للشعوب يعلمنا، أن الدول التي تأخذ الطريق السليمة للنمو، ترتقي بسرعة. فاليابان التي دمرت بالقنابل النووية، لم تمض عليها 24 سنة حتى قفزت إلى مرتبة القوة الاقتصادية الثالثة، على مستوى العالم. والصين التي أفقدها الفقر عشرات الملايين من أبنائها في الستينات، لم تمض عليها ثلاثة عقود، بعد أن أخذت الطريق السليمة للتنمية، على يد دينغ هسياوبينغ، حتى أصبحت القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم، وهاهي الآن تستعد لانتزاع العرش الاقتصادي من الولايات المتحدة، خلال سنوات محدودة، كما يقول الخبراء.
والبرازيل التي تولى الرئيس لولا سلفا رئاستها، وهي من أكبر المدينين للبنك الدولي، لم يغادر رئاستها إلا بعد أن أصبحت هي التي تقرض البنك الدولي. وتشبه مسيرة هذه الدول، مسيرات عدد آخر من الدول الناجحة اقتصاديا، مثل: تركيا الحالية، وإسرائيل، وماليزيا، وكوريا الجنوبية.. الخ.
أما موريتانيا، فبعد 56 سنة من الاستقلال، والمجالس العسكرية والمدنية، تفتخر وزيرة في حكومتها، بأننا تمكنا أخيرا، من فقس بيض الدجاج محليا، بدل استيراد الكتاكيت من الخارج..!.
إننا إلى حوار تنموي يقوم الخلل، أحوج منا إلى حوار سياسي، يضع قواعد تقاسم كعكة السلطة، في بلد هذه حالته المزرية.
وأعتقد أن من أبرز مظاهر التشوه التنموي، التي أوصلتنا إلى هذا الإخفاق، والتي يضيق المجال عن تناولها، تجاهلنا لثرواتنا الزراعية، واستنزافنا أرصدتنا من العملة الصعبة، في شراء غذائنا من الخارج، بدل توجيه هذه الموارد لانتاجه محليا، مما يوفر فرص العمل، ويحارب الفقر، ويعزز سيادتنا الغذائية.
وتجنب إسرائيل لمثل هذا الاستنزاف الاقتصادي، الذي وقعنا فيه، هو الذي ساهم في وصول اقتصادها، إلى ما وصل إليه من تقدم، بعد أن أمنت الاكتفاء الذاتي من الغذاء، خلال الأربع عشرة سنة الأولى من قيامها.
أما شعبنا الفقير، فهو ينفق سنويا 22.700.000.000 أوقية، في استيراد الحليب ومشتقاته، بينما يمتلك أكثر من 20.000.000 رأس من الحيوانات، حسب وزير المالية والاقتصاد. كما ينفق أكثر من 43.000.000.000 أوقية سنويا على استيراد القمح، و 18.500.000.000 أوقية على استيراد الأرز، برغم امتلاكه 513.000 هكتار من الأراضي العالية الخصوبة، التي تكاد تكون كلها مهدورة. ناهيك عما ينفق في استيراد السكر، وزيوت الطبخ والفاكهة، وغيرها من المواد الزراعية، التي يسهل إنتاجها محليا.
إن العقل الاقتصادي في بلادنا يبدو كما لو كان في إجازة مفتوحة.
ويأتي الفساد، وهو الخطر الثالث، الذي يهدد مستقبل دولتنا، ليزيد من وقع الإخفاق التنموي. فقد تضاعفت وتيرة النهب خلال العقود الأخيرة، حتى وصل إلى مرحلة نهب القيم الاجتماعية، ونشر ثقافة الاستهلاك، بين هذا المجتمع البدوي، القنوع بطبعه. فغدا هذا المجتمع المدجن، الذي كانت السرقة، حتى أمس القريب، أكبر قادح في كلابه، يبجل الناهب، ويلتف حوله، حتى يحوله بمكانته الجديدة، إلى "ناخب كبير"، يخطب السياسيون وده، وتعصمه منزلته العالية، من "تطاول" العدالة عليه. وهكذا حطم المفسدون، خط الدفاع الأقوى، في وجه سرقة المال العام، المتمثل في الرقيب الاجتماعي. ومن هنا، كان النزيف الأخلاقي، الذي سببه الفساد، أشد خطرا على كيان الدولة، من النزيف الاقتصادي. لكنه بالطبع، ليس أشد خطرا من التصدع الاجتماعي، الذي تعاون الفساد والإخفاق التنموي على توسيع شرخه.
فهذا الشعب الذي يعاني نحو نصفه من الفقر والحرمان، حتى من المياه الصالحة للشرب والكهرباء، تجد فردا أو أفرادا من بينه، ينهبون المليارات من الأوقية، تكفي لإخراج عشرات القرى المحرومة من وضعيتها المزرية.
ولما كانت "فرصة النهب"، مرتبطة بتولي وظائف، ومسئوليات محددة، وكان أبناء إحدى الشرائح الاجتماعية، مهيئين في مرحلة معينة، أكثر من غيرهم، لتولي هذه المناصب، بفعل عوامل تاريخية واجتماعية، كان النهب للأسف غير موزع بمساواة بين الشرائح المختلفة. وهكذا حول الغضب والشعور بالظلم، الناهب في أعين المحرومين، إلى شريحة وليس أفرادا. وبدأت التوترات الاجتماعية الناتجة عن الفساد تأخذ، أبعادا عنصرية، وتدفع إلى المزيد من تآكل النسيج الاجتماعي، وهذه هي الجناية الثالثة للمفسدين، في حق هذا المجتمع.
وما نفعله حتى الآن، لتقليل مخاطر ذلك التوتر، ولتصحيح ذلك الخلل، هو الكثير من الكلام، والقليل من الأفعال. والواقع المعيشي والتعليمي في آدوابه، لا يترك مجالا للجدل حول تقصيرنا.
أما الخطر الرابع على مستقبل الدولة فيأتي من الجيش..! إنه الجيش الوطني، الذي يعتبر أبرز حماة وحدتنا الوطنية، والضامن الأساسي لسيادتنا واستقلالنا الوطني.
وإذا ما أردنا الدقة، فلنقل إن الخطر يأتي من الطموح السياسي لبعض ضباط الجيش، وانتشار ثقافة تعتبر الجيش وصيا على إرادة الشعب الموريتاني، وترى التغيير عبر الانقلابات العسكرية أمرا طبيعيا. وهي ثقافة يغذيها تاريخ عريق من الانقلابات، والاغتيالات السياسية في سبيل "الفوز بالزعامة"، في إماراتنا التقليدية المختلفة، التي ترى كل من يفوز في هذه الصراعات، زعيما شرعيا وبطلا "من أصحاب الشان".
ومكافحة هذه الثقافة، التي لا تتم إلا مع الوقت، ينبغي أن تكون عبر محورين: المناهج التعليمية، بما فيها مناهج المدارس والكليات العسكرية، ثم ترسيخ مبدأ التناوب السلمي على السلطة، من خلال الممارسة العملية، لفتح نافذة أمل للتغيير السلمي.
ويكمن الخطر الأساسي من الانقلابات العسكرية، في إمكانية انقسام الجيش إلى جبهتين، لا تتمكن إحداهما من حسم الصراع بسرعة، مما يوفر فرصة للجيران، ليدعم كل منهم، الطرف الذي يرى أنه الأقدر على تأمين مصالحه في الكعكة الموريتانية، التي ينطبق عليها عندئذ المثل الشعبي المصري: "البقرة إذا وقعت كثروا اسكاكينها" (أي أن البقرة إذا وقعت أرضا أتى كل جزار من جهته بسكينه ليقطع ما يليه).
ومعروف عن جيراننا شهيتهم المفتوحة إلى القضم، إذ لا يوجد من جيران موريتانيا من لم يطالب بها أو بجزء منها إلا الجزائر.
وفي مثل هذه الحالة من الحرب الأهلية، أبعد الله شرورها عن وطننا، سرعان ما تتدخل الدول الكبرى، لتتبنى كل منها طرفها المفضل، وبذا تخرج مفاتيح التسوية، وزمام المبادرة، من أيدي المتحاربين. ولنا فيما حدث في انقلاب 2003 عبرة واضحة. فلولا أن الفارق، في قوة النيران بين طرفي الجيش، ذلك اليوم كان كبيرا جدا، ولولا أن ثمة رجالا ذوي ضمائر حية، آثروا تجرع مرارة الهزيمة، على جريان أنهر الدماء من أبناء شعبهم، لكان لله في خلقه، من الموريتانيين، شأن غير الذي رأيناه.
ويكمن الخطر الخامس، في المحسوبية في التعيينات، حيث تحرم الدولة من قدر كبير من كفاءاتها، ويتم تجاوزهم في التعيينات، إلى أقارب وأصحاب ذوي النفوذ، ليخلد ألائك الأكفاء في قاع الإدارة والوزارة، مهمشين، ومدارين من قبل معينين "نزلوا بالمظلة"، يرون في كل ذي علم ومعرفة عدوا تجب محاربته. وكيف يكون تقدم إدارتنا إذا جعلنا عاليها سافلها؟ إنه سبب آخر من أسباب الإخفاق التنموي.
وليس بعيدا من هذا الظلم، مبدأ عدالة الأقوى، الذي ما يزال يجد له مكانا بيننا، وهو الخطر السادس على دولتنا. فما زال بإمكان القوي، مصادرة حق الضعيف، في أسوأ الاحتمالات، وتعطيله إلى أجل غير مسمى، في أحسن الحالات. والدولة تستقيم على الكفر، ولا تستقيم على الظلم. وهذه ظاهرة تقوض، في ذهن المواطن، فكرة الدولة من أساسها.
وقد يكون في المزيد من فصل السلطات، واستقلال القضاء، ما يحجم خطر هذه الظاهرة.
تلك بصورة عامة، أبرز –لا كل- المخاطر التي تهدد مستقبل الجمهورية الإسلامية الموريتانية. فأين هذا من الجواب على السؤال المعضل؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقد تحملت وزر طرح السؤال، فليتحمل غيري تكملة المقال. أما إذا كان لابد من المساهمة في إضاءة معالم الطريق، فأقول إن نوع النخب التي سنسمح بأن تحكمنا، خلال العقود المقبلة، والطريقة التي ستتعامل بها هذه النخب، لتفكيك ألغام هذه المخاطر الستة، هي التي ستحدد إن كان لموريتانيا مستقبل، أم أنها ستمثل مجرد ومضة تاريخية، قد تزيد على ومضة دولة أبي بكر بن عامر، بجيلين أو ثلاثة، لكن لعنة صحراء الملثمين ستكون أقوى منها.
وبعبارة أخرى، سيكون لهذه الدولة مستقبل، إذا قيض الله لها، خلال العقود المقبلة، نخبا من بناة الدول، لا بناة الأرصدة، تحدث في مسارها انعطافا قويا، كذلك الذي يحدثه الملاح، في الضباب، عندما يكتشف فجأة، أمام سفينته، جبلا جليديا هائلا، توشك أن تصطدم به.
أما إن كانت الأخرى، فلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
والله المستعان على ما تصفون.
بقلم: يحيى بن بـيـبه
رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي
البريد الألكتروني:[email protected]


.jpg)
.gif)








.gif)
.jpg)